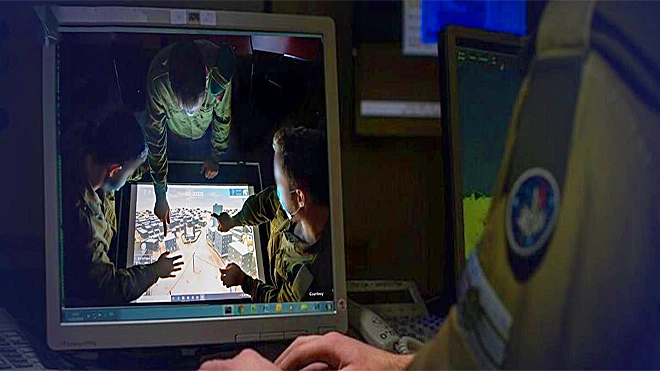ذلك الذي يأتي.. كان الأستاذ يأتي إلى هنا كل عام يحاضر، يحفز، يحرض، يعلم يقدم أطروحات ومشاريع، وخطوط عمل لمعارضة المستقبل، كان يحاول أن يرسي تقليداً، ويسعى بكل الحرص وبكثير من الجهد إلى تفريخ أشكال جديدة من المعارضة بين أوساط محبيه ومريديه.
وبين العام والعام كان الأستاذ يكتب ناقداً محرضاً كاشفاً عورات البعض مصنفاً بريق الجموع الصامتة.. كان يجول البلاد معدياً بؤس المعارضة وربما توجيه النظام والجموع الصامتة أيضاً، وكأني به يتمثل قول بشار:
إني لأفتح عيني حين أفتحها
على كثير ولكن لا أرى أحداً
كانت أطروحات الأستاذ تثير تساؤلات الجميع الحائر، وشجاعته تثير غيرة الجميع -التمني ليس إلا- وجرأته تذكر أحفاد الرجال بأزمات خلت وبحكايات أبطال السير الشعبية، كان الأستاذ مركباً استثنائياً في زمن غير استثنائي، وطنياً حتى نخاع العظم، معارضاً أسطورياً، مثقفاً موسوعياً، إنساناً مخلقاً، درويشاً من دراويش الصوفية، صعلوكاً من صعاليك الشعر، صديقاً ودوداً مربياً فذاً، أباً للجميع.
كان الأستاذ عفيفاً في زمن لص، قانعاً في زمن أصحابه وزبانيته ومريدوه وواجهاته، لصوص في لصوص.
في زمن الأستاذ، كانت للأشياء مضامين وللألفاظ، وللضحكات رونق، وللمواقف معاني، كان الأستاذ حالماً عظيماً يسعى لتلوين الأشياء بخطوط جمال، كان يسعى ليضفي على الأشياء لمسات من جمال ثوريتها رغم قبحها الظاهر وكساحها المزمن.
كان الأستاذ عبداً من عبيد الله الصالحين متعاطفاً مع ضعف الآخرين، كان يغفر ويسامح ويتسامح، كان يلتمس للجميع العذر على الرغم من طبيعتهم السوداوية تجاهه.
كان الأستاذ يكشف ظهره وهو يعرف أن نبالاً كثيرة تحاول النيل منه، وكأني به يقول: (ها أنا أحمل خشبتي على ظهري، وأطلب من يصلبني عليها.. ولا أجد).
وكان يكشف روحه وهو يعرف أن كثيرين يسعون لتلويثها، وكأني به يتمثل بقول سيدنا عيسى عليه السلام: (من كان منكم بلا خطيئة فلير مها بحجر) ويعرف أن في دواخل وظواهر الساعين تلويثه أوزاراً وخطايا تثنى منها الجبال، وكان يتحصن ويحصن نفسه منهم بطيبته مقابل خبثهم، وبرهافته مقابل عنجهيتهم، وبجمال روحه مقابل قبحهم كان يتحصن بقوله تعالى (وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين) وبقوله تعالى (ولا تكن الخائنين خصيما). لا كما فسرها منصوراً بالعصبية، بل كما فسرت بروح الإسلام وباطنه وظاهرة.
وعلى الرغم من أن الأستاذ لم يكن يحمل إلا عصاه، مقابل أنيابهم الملوثة بالدم، والمشعوذة بتاريخهم الغابر.. فقد انتصر عليهم إلى يوم الدين، كان الأستاذ هالة من نور، وبلسماً شافياً، وحضوراً طاغياً، ومحباً عظيماً.
وكان بطلاً تر اجيدياً يحمل خشبته على ظهره ولا يجد من يصلبه عليها ، كان الجميع برفقة الأستاذ أبطالاً صناديد، وسفراء مجيدين، ومعارضين يسمع لهم صوت ورحماء فيما بينهم، وحالمين عظام ، وأصحاب مشاريع مستقبل، لأن رفقته كانت تعدي، وبفقده حضوراً ورمزاً (لأننا شعب نكره البطولة ونقتل الأبطال) توارث البطولة، وتوارى رونق الشعب، وانزوت المعارضة وتفرقت، وخلت الساحة إلا من مهرجين أو نصابين أو أكلة سحت.
وما عاد الحديث في السياسة وفي زمن معارضة العلوم يسر صديقاً ولا يفهمه عدواً ، الزمن السياسي بعد الأستاذ ليس كالزمن السياسي قبله محالاً كحال القائل: لقد عشت في زمان وأدركت أقواماً لو احتفلت الدنيا ما تجملت إلا بهم، وإني الآن لفي زمان ما أرى فيه عاقلاً حصيفاً ولا ناسكاً عفيفاً، ولا من يساوي على الخضرة رغيفاً، ولم يعد زمن الحالمين مع الأستاذ كزمن الحالمين بعده، ألم يقل أحدهم من قديم يعبر عن حالنا اليوم:
فما الناس بالناس الذين عرفتهم
ولا الدار بالدار التي كنت أعرف
وبين العام والعام كان الأستاذ يكتب ناقداً محرضاً كاشفاً عورات البعض مصنفاً بريق الجموع الصامتة.. كان يجول البلاد معدياً بؤس المعارضة وربما توجيه النظام والجموع الصامتة أيضاً، وكأني به يتمثل قول بشار:
إني لأفتح عيني حين أفتحها
على كثير ولكن لا أرى أحداً
كانت أطروحات الأستاذ تثير تساؤلات الجميع الحائر، وشجاعته تثير غيرة الجميع -التمني ليس إلا- وجرأته تذكر أحفاد الرجال بأزمات خلت وبحكايات أبطال السير الشعبية، كان الأستاذ مركباً استثنائياً في زمن غير استثنائي، وطنياً حتى نخاع العظم، معارضاً أسطورياً، مثقفاً موسوعياً، إنساناً مخلقاً، درويشاً من دراويش الصوفية، صعلوكاً من صعاليك الشعر، صديقاً ودوداً مربياً فذاً، أباً للجميع.
كان الأستاذ عفيفاً في زمن لص، قانعاً في زمن أصحابه وزبانيته ومريدوه وواجهاته، لصوص في لصوص.
في زمن الأستاذ، كانت للأشياء مضامين وللألفاظ، وللضحكات رونق، وللمواقف معاني، كان الأستاذ حالماً عظيماً يسعى لتلوين الأشياء بخطوط جمال، كان يسعى ليضفي على الأشياء لمسات من جمال ثوريتها رغم قبحها الظاهر وكساحها المزمن.
كان الأستاذ عبداً من عبيد الله الصالحين متعاطفاً مع ضعف الآخرين، كان يغفر ويسامح ويتسامح، كان يلتمس للجميع العذر على الرغم من طبيعتهم السوداوية تجاهه.
كان الأستاذ يكشف ظهره وهو يعرف أن نبالاً كثيرة تحاول النيل منه، وكأني به يقول: (ها أنا أحمل خشبتي على ظهري، وأطلب من يصلبني عليها.. ولا أجد).
وكان يكشف روحه وهو يعرف أن كثيرين يسعون لتلويثها، وكأني به يتمثل بقول سيدنا عيسى عليه السلام: (من كان منكم بلا خطيئة فلير مها بحجر) ويعرف أن في دواخل وظواهر الساعين تلويثه أوزاراً وخطايا تثنى منها الجبال، وكان يتحصن ويحصن نفسه منهم بطيبته مقابل خبثهم، وبرهافته مقابل عنجهيتهم، وبجمال روحه مقابل قبحهم كان يتحصن بقوله تعالى (وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين) وبقوله تعالى (ولا تكن الخائنين خصيما). لا كما فسرها منصوراً بالعصبية، بل كما فسرت بروح الإسلام وباطنه وظاهرة.
وعلى الرغم من أن الأستاذ لم يكن يحمل إلا عصاه، مقابل أنيابهم الملوثة بالدم، والمشعوذة بتاريخهم الغابر.. فقد انتصر عليهم إلى يوم الدين، كان الأستاذ هالة من نور، وبلسماً شافياً، وحضوراً طاغياً، ومحباً عظيماً.
وكان بطلاً تر اجيدياً يحمل خشبته على ظهره ولا يجد من يصلبه عليها ، كان الجميع برفقة الأستاذ أبطالاً صناديد، وسفراء مجيدين، ومعارضين يسمع لهم صوت ورحماء فيما بينهم، وحالمين عظام ، وأصحاب مشاريع مستقبل، لأن رفقته كانت تعدي، وبفقده حضوراً ورمزاً (لأننا شعب نكره البطولة ونقتل الأبطال) توارث البطولة، وتوارى رونق الشعب، وانزوت المعارضة وتفرقت، وخلت الساحة إلا من مهرجين أو نصابين أو أكلة سحت.
وما عاد الحديث في السياسة وفي زمن معارضة العلوم يسر صديقاً ولا يفهمه عدواً ، الزمن السياسي بعد الأستاذ ليس كالزمن السياسي قبله محالاً كحال القائل: لقد عشت في زمان وأدركت أقواماً لو احتفلت الدنيا ما تجملت إلا بهم، وإني الآن لفي زمان ما أرى فيه عاقلاً حصيفاً ولا ناسكاً عفيفاً، ولا من يساوي على الخضرة رغيفاً، ولم يعد زمن الحالمين مع الأستاذ كزمن الحالمين بعده، ألم يقل أحدهم من قديم يعبر عن حالنا اليوم:
فما الناس بالناس الذين عرفتهم
ولا الدار بالدار التي كنت أعرف