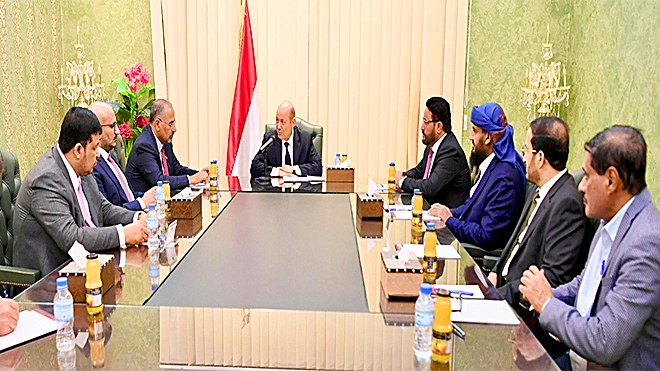لم يعد في الإمكان إخفاء حقيقة أن اليمن الذي رسمته اتفاقية الوحدة قد مات، فلا توجد دولة مركزية ولا توجد شرعية جامعة ولا يمكن لميليشيا طائفية أن تحكم 30 مليون نسمة بقوة السلاح.
في منتصف عام 2025 لا يبدو الشرق الأوسط كما كان قبل سنوات قليلة، الزلازل الجيوسياسية التي ضربت المنطقة، من الحرب الإسرائيلية – الإيرانية القصيرة، إلى سقوط النظام السوري، أعادت تشكيل خطوط النفوذ، وأجبرت العواصم الكبرى على مراجعة حساباتها وتحالفاتها، ورغم أن الضوء غالبا ما يُسلّط على غزة وطهران ودمشق، فإن اليمن ظل في قلب تلك التصدعات، ليس باعتباره “هامشا منسيا”، بل كنقطة توازن إقليمي اختلّت بفعل السياسات المؤجلة والتقديرات الخاطئة.
منذ أن تحررت عدن في يوليو 2015، سنحت لحظة تاريخية لإعادة صياغة المشهد اليمني، وفق مقاربة تعترف بالتحولات الواقعية على الأرض، وفي مقدمتها القضية الجنوبية، غير أن تلك اللحظة أُجهضت تحت ضغط اعتبارات “الشرعية الشكلية” وتحالفات مؤقتة مع أطراف ثبت لاحقا أنها تقف على النقيض من مفهوم الدولة، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين التي اخترقت بنية ما سُمّي بـ ”الجيش الوطني” وحوّلته إلى ذراع أيديولوجية.
لقد تعامل المجتمع الدولي مع الملف اليمني وفق سياسة الترحيل، ظنا أن وقف إطلاق النار وحده يكفي لتجميد الصراع، وأن “إدارة الأزمة” يمكن أن تغني عن حلّها، غير أن السنوات الأخيرة أثبتت هشاشة هذا التصوّر، فالحوثيون، الذين خرجوا من عباءة الثورة الإيرانية، لم يعودوا مجرد ميليشيا محلية بل أصبحوا يمتلكون ترسانة صاروخية متطورة، توازي – بل تتفوق أحيانا – على ترسانة حزب الله اللبناني، وتسمح لهم بتهديد البحر الأحمر، واستهداف إسرائيل، وفرض وقائع على الأرض بقوة النار.
وفي لحظة الانكشاف الاستراتيجي التي شهدتها إيران عقب الضربات الإسرائيلية – الأميركية في يونيو، أعلن الحوثيون صراحة أن اتفاق وقف إطلاق النار لا يشملهم، هذا الإعلان لم يكن مجرد استعراض خطاب، بل إشارة إلى أن اليمن، بـ ”موقعه الاستراتيجي”، بات ساحة مفتوحة لكل الاحتمالات، من المواجهة الإقليمية إلى التدويل الكامل للصراع.
لكن الأخطر من ذلك، أن المجتمع الدولي بدأ يستشعر متأخرا حجم الانفلات الذي تركه الحوثيون في خاصرة الجزيرة العربية، لقد كانت الهجمات الحوثية على السفن التجارية في البحر الأحمر بمثابة إنذار حقيقي بأن هذه الجماعة لم تعد مجرد “ورقة ضغط”، بل باتت تُمثّل تهديدا مباشرا للتجارة العالمية، وخطوط الطاقة، واستقرار الممرات الدولية، فالغياب الدولي عن وضع تعريف دقيق للحوثيين كجماعة إرهابية متصلة بالحرس الثوري الإيراني سمح لها بالمناورة والتوسع، تحت غطاء “الحل السلمي”، في وقتٍ كانت تُراكم فيه ترسانة أكبر من تلك التي يمتلكها حزب الله.
وهنا يبرز سؤال استراتيجي لا يمكن تجاهله: لماذا يتم التعامل مع اليمن كملف يمكن ترحيله، بينما يتم التعامل مع ملفات أخرى مثل البرنامج النووي الإيراني أو الحرب في أوكرانيا كأولويات أمن قومي دولي؟ أليس أمن باب المندب والبحر الأحمر جزءا من معادلة الأمن العالمي؟ أليس الاستقرار في عدن والمكلا والمهرة مدخلا أساسيا لضبط إيقاع البحر العربي والخليج من جهة، والقرن الأفريقي من جهة أخرى؟
هنا، تبدو القضية الجنوبية – بكل تعقيداتها – أكثر القضايا وضوحا من حيث التوصيف السياسي والاستحقاق الوطني، فهي ليست حركة انفصالية عابرة، بل امتداد لتاريخ سياسي معروف، وتجربة دولية سابقة، وحراك شعبي طويل الأمد عبّر عن نفسه في أكثر من محطة، وما لم يتم الاعتراف الجاد بهذه القضية، بوصفها مدخلا لحلحلة العقدة اليمنية، فإن كل المسارات الأخرى ستظل تدور في حلقة مفرغة.
الجنوب لم يكن في يوم من الأيام طرفا متفرجا على الصراع، بل كان في طليعة المواجهة مع المشروع الإيراني، وعندما كانت عدن تقاتل وحدها في مارس 2015، لم تكن تفكر في خرائط النفوذ، بل كانت تدافع عن كينونتها وعن إرادة شعبها في العيش بكرامة، لكن حين جاء القرار الدولي، قفز على التضحيات، واحتكم إلى شرعية مهترئة تستمد وجودها من غرف فنادق الخارج لا من واقع الداخل.
اليوم، وبعد مرور عشر سنوات على اندلاع الحرب، لم يعد في الإمكان إخفاء حقيقة أن اليمن الذي رسمته اتفاقية الوحدة عام 1990 قد مات، فلا توجد دولة مركزية، ولا توجد شرعية جامعة، ولا يمكن لميليشيا طائفية أن تحكم 30 مليون نسمة بقوة السلاح، ولا لطرف واحد أن يحتكر تمثيل اليمنيين بموجب خطاب سياسي تجاوزه الزمن.
وإذا كانت المنطقة قد بدأت تتجه نحو إعادة تعريف “النفوذ”، و ”الشرعية”، و ”الحلول الواقعية”، فإن اليمن في حاجة إلى قرار، لا إلى المزيد من الترحيل، قرار يعترف أولا بأن الجنوب له حق تقرير مصيره، كما نصت عليه مخرجات الحوار الوطني ذاته قبل أن تُجهضها الميليشيات والتحالفات الهشة، وقرار يعيد صياغة العلاقة بين الشمال والجنوب على أسس ندية، تحفظ للشعوب كرامتها وتمنح للدولة معناها.
التمسك بالصيغة الفاشلة ذاتها، واستمرار التعاطي مع القضية الجنوبية كـ ”تفصيل مزعج” أو “ملف مؤجل”، لا يؤدي سوى إلى المزيد من التدهور، فالمشهد في صنعاء مغلق، والمفاوضات مع الحوثيين لم تحقق سوى تثبيت واقع الانقلاب، بينما الجنوب يعيش حالة نضج سياسي وأمني تستحق أن يُبنى عليها، لا أن تُحاصر.
في ظل الانسحاب الأميركي المتدرج من إدارة التفاصيل اليومية للصراعات، واتساع هامش المناورة أمام اللاعبين الإقليميين، فإن القوى الكبرى تدرك الآن أن ترك اليمن في حالته الراهنة يمثل خطرا على أمن البحر الأحمر والممرات الدولية، والاعتراف بالمجلس الانتقالي الجنوبي وقضيته ليس مجاملة، بل ضرورة جيوسياسية لتثبيت الاستقرار، لاسيما في ظل تحوّل اليمن إلى ساحة تتقاطع فيها مصالح الصين، وروسيا، وإيران، ودول القرن الأفريقي.
آن الأوان أن يعاد تعريف الحل في اليمن من نقطة البدء الصحيحة: الجنوب، فهو ليس مشكلة تُحلّ لاحقا، بل مفتاحٌ لبناء نموذج جديد، ينطلق من الواقع، ويكسر قيد الصيغ المهترئة، ويفتح الباب أمام سلام حقيقي، لا هدنة بين ميليشيات متصارعة.
لا يمكن للمنطقة أن تتجاوز أزماتها دون أن تنطلق من أكثر الملفات وضوحا: اليمن، والواقع أن بوابة اليمن لا تُفتح من صنعاء بل من عدن، فالجنوب ليس مجرد جغرافيا، بل مشروع دولة يُبنى من رحم المعاناة، ويملك مقومات النجاح، وبدلا من استمرار الضغط عليه ليبقى رهينة خيارات الآخرين، فإن الاعتراف به شريكا كاملا هو الخطوة الأولى لبناء هندسة أمن إقليمي جديدة، هندسة تقوم على الواقعية لا الوهم، وعلى استيعاب التحولات بدل دفن الرأس في رمال الخرائط القديمة.
إن المأزق اليمني ليس انعكاسا لعجز داخلي فقط، بل مرآة لفشل المقاربات الدولية التي سعت إلى “تجميد” الصراع بدل حسمه، وإلى احتواء الحوثي بدل ردعه، واليوم، حين تقف المنطقة على أعتاب تحولات جذرية، فإن جنوب اليمن يقدم فرصة نادرة لإعادة تعريف الممكن السياسي، وبناء نموذج توازني في زمن الفوضى، سياسة الترحيل فيما يختص بقضية الجنوب آن لها أن تنتهي فلا حلّ سيأتي من طهران ولا من صنعاء، كل الحلول تأتي من عدن.
"العرب اللندنية"
في منتصف عام 2025 لا يبدو الشرق الأوسط كما كان قبل سنوات قليلة، الزلازل الجيوسياسية التي ضربت المنطقة، من الحرب الإسرائيلية – الإيرانية القصيرة، إلى سقوط النظام السوري، أعادت تشكيل خطوط النفوذ، وأجبرت العواصم الكبرى على مراجعة حساباتها وتحالفاتها، ورغم أن الضوء غالبا ما يُسلّط على غزة وطهران ودمشق، فإن اليمن ظل في قلب تلك التصدعات، ليس باعتباره “هامشا منسيا”، بل كنقطة توازن إقليمي اختلّت بفعل السياسات المؤجلة والتقديرات الخاطئة.
منذ أن تحررت عدن في يوليو 2015، سنحت لحظة تاريخية لإعادة صياغة المشهد اليمني، وفق مقاربة تعترف بالتحولات الواقعية على الأرض، وفي مقدمتها القضية الجنوبية، غير أن تلك اللحظة أُجهضت تحت ضغط اعتبارات “الشرعية الشكلية” وتحالفات مؤقتة مع أطراف ثبت لاحقا أنها تقف على النقيض من مفهوم الدولة، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين التي اخترقت بنية ما سُمّي بـ ”الجيش الوطني” وحوّلته إلى ذراع أيديولوجية.
لقد تعامل المجتمع الدولي مع الملف اليمني وفق سياسة الترحيل، ظنا أن وقف إطلاق النار وحده يكفي لتجميد الصراع، وأن “إدارة الأزمة” يمكن أن تغني عن حلّها، غير أن السنوات الأخيرة أثبتت هشاشة هذا التصوّر، فالحوثيون، الذين خرجوا من عباءة الثورة الإيرانية، لم يعودوا مجرد ميليشيا محلية بل أصبحوا يمتلكون ترسانة صاروخية متطورة، توازي – بل تتفوق أحيانا – على ترسانة حزب الله اللبناني، وتسمح لهم بتهديد البحر الأحمر، واستهداف إسرائيل، وفرض وقائع على الأرض بقوة النار.
وفي لحظة الانكشاف الاستراتيجي التي شهدتها إيران عقب الضربات الإسرائيلية – الأميركية في يونيو، أعلن الحوثيون صراحة أن اتفاق وقف إطلاق النار لا يشملهم، هذا الإعلان لم يكن مجرد استعراض خطاب، بل إشارة إلى أن اليمن، بـ ”موقعه الاستراتيجي”، بات ساحة مفتوحة لكل الاحتمالات، من المواجهة الإقليمية إلى التدويل الكامل للصراع.
لكن الأخطر من ذلك، أن المجتمع الدولي بدأ يستشعر متأخرا حجم الانفلات الذي تركه الحوثيون في خاصرة الجزيرة العربية، لقد كانت الهجمات الحوثية على السفن التجارية في البحر الأحمر بمثابة إنذار حقيقي بأن هذه الجماعة لم تعد مجرد “ورقة ضغط”، بل باتت تُمثّل تهديدا مباشرا للتجارة العالمية، وخطوط الطاقة، واستقرار الممرات الدولية، فالغياب الدولي عن وضع تعريف دقيق للحوثيين كجماعة إرهابية متصلة بالحرس الثوري الإيراني سمح لها بالمناورة والتوسع، تحت غطاء “الحل السلمي”، في وقتٍ كانت تُراكم فيه ترسانة أكبر من تلك التي يمتلكها حزب الله.
وهنا يبرز سؤال استراتيجي لا يمكن تجاهله: لماذا يتم التعامل مع اليمن كملف يمكن ترحيله، بينما يتم التعامل مع ملفات أخرى مثل البرنامج النووي الإيراني أو الحرب في أوكرانيا كأولويات أمن قومي دولي؟ أليس أمن باب المندب والبحر الأحمر جزءا من معادلة الأمن العالمي؟ أليس الاستقرار في عدن والمكلا والمهرة مدخلا أساسيا لضبط إيقاع البحر العربي والخليج من جهة، والقرن الأفريقي من جهة أخرى؟
هنا، تبدو القضية الجنوبية – بكل تعقيداتها – أكثر القضايا وضوحا من حيث التوصيف السياسي والاستحقاق الوطني، فهي ليست حركة انفصالية عابرة، بل امتداد لتاريخ سياسي معروف، وتجربة دولية سابقة، وحراك شعبي طويل الأمد عبّر عن نفسه في أكثر من محطة، وما لم يتم الاعتراف الجاد بهذه القضية، بوصفها مدخلا لحلحلة العقدة اليمنية، فإن كل المسارات الأخرى ستظل تدور في حلقة مفرغة.
الجنوب لم يكن في يوم من الأيام طرفا متفرجا على الصراع، بل كان في طليعة المواجهة مع المشروع الإيراني، وعندما كانت عدن تقاتل وحدها في مارس 2015، لم تكن تفكر في خرائط النفوذ، بل كانت تدافع عن كينونتها وعن إرادة شعبها في العيش بكرامة، لكن حين جاء القرار الدولي، قفز على التضحيات، واحتكم إلى شرعية مهترئة تستمد وجودها من غرف فنادق الخارج لا من واقع الداخل.
اليوم، وبعد مرور عشر سنوات على اندلاع الحرب، لم يعد في الإمكان إخفاء حقيقة أن اليمن الذي رسمته اتفاقية الوحدة عام 1990 قد مات، فلا توجد دولة مركزية، ولا توجد شرعية جامعة، ولا يمكن لميليشيا طائفية أن تحكم 30 مليون نسمة بقوة السلاح، ولا لطرف واحد أن يحتكر تمثيل اليمنيين بموجب خطاب سياسي تجاوزه الزمن.
وإذا كانت المنطقة قد بدأت تتجه نحو إعادة تعريف “النفوذ”، و ”الشرعية”، و ”الحلول الواقعية”، فإن اليمن في حاجة إلى قرار، لا إلى المزيد من الترحيل، قرار يعترف أولا بأن الجنوب له حق تقرير مصيره، كما نصت عليه مخرجات الحوار الوطني ذاته قبل أن تُجهضها الميليشيات والتحالفات الهشة، وقرار يعيد صياغة العلاقة بين الشمال والجنوب على أسس ندية، تحفظ للشعوب كرامتها وتمنح للدولة معناها.
التمسك بالصيغة الفاشلة ذاتها، واستمرار التعاطي مع القضية الجنوبية كـ ”تفصيل مزعج” أو “ملف مؤجل”، لا يؤدي سوى إلى المزيد من التدهور، فالمشهد في صنعاء مغلق، والمفاوضات مع الحوثيين لم تحقق سوى تثبيت واقع الانقلاب، بينما الجنوب يعيش حالة نضج سياسي وأمني تستحق أن يُبنى عليها، لا أن تُحاصر.
في ظل الانسحاب الأميركي المتدرج من إدارة التفاصيل اليومية للصراعات، واتساع هامش المناورة أمام اللاعبين الإقليميين، فإن القوى الكبرى تدرك الآن أن ترك اليمن في حالته الراهنة يمثل خطرا على أمن البحر الأحمر والممرات الدولية، والاعتراف بالمجلس الانتقالي الجنوبي وقضيته ليس مجاملة، بل ضرورة جيوسياسية لتثبيت الاستقرار، لاسيما في ظل تحوّل اليمن إلى ساحة تتقاطع فيها مصالح الصين، وروسيا، وإيران، ودول القرن الأفريقي.
آن الأوان أن يعاد تعريف الحل في اليمن من نقطة البدء الصحيحة: الجنوب، فهو ليس مشكلة تُحلّ لاحقا، بل مفتاحٌ لبناء نموذج جديد، ينطلق من الواقع، ويكسر قيد الصيغ المهترئة، ويفتح الباب أمام سلام حقيقي، لا هدنة بين ميليشيات متصارعة.
لا يمكن للمنطقة أن تتجاوز أزماتها دون أن تنطلق من أكثر الملفات وضوحا: اليمن، والواقع أن بوابة اليمن لا تُفتح من صنعاء بل من عدن، فالجنوب ليس مجرد جغرافيا، بل مشروع دولة يُبنى من رحم المعاناة، ويملك مقومات النجاح، وبدلا من استمرار الضغط عليه ليبقى رهينة خيارات الآخرين، فإن الاعتراف به شريكا كاملا هو الخطوة الأولى لبناء هندسة أمن إقليمي جديدة، هندسة تقوم على الواقعية لا الوهم، وعلى استيعاب التحولات بدل دفن الرأس في رمال الخرائط القديمة.
إن المأزق اليمني ليس انعكاسا لعجز داخلي فقط، بل مرآة لفشل المقاربات الدولية التي سعت إلى “تجميد” الصراع بدل حسمه، وإلى احتواء الحوثي بدل ردعه، واليوم، حين تقف المنطقة على أعتاب تحولات جذرية، فإن جنوب اليمن يقدم فرصة نادرة لإعادة تعريف الممكن السياسي، وبناء نموذج توازني في زمن الفوضى، سياسة الترحيل فيما يختص بقضية الجنوب آن لها أن تنتهي فلا حلّ سيأتي من طهران ولا من صنعاء، كل الحلول تأتي من عدن.
"العرب اللندنية"