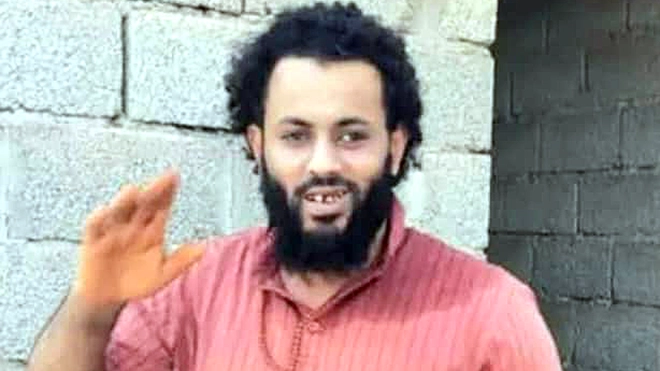> «الأيام» د. سعودي علي عبيد:
لقد كتبت ونشرت العديد من الدراسات والأبحاث والمقالات وغيرها عن ظاهرة الثأر في اليمن، وأزيد بالقول إننا نسمع ونقرأ يومياً على وجه التقريب، عن حوادث الثأر في هذه المنطقة أو تلك، ولا غرابة إذا ما صرحت بأن بعضنا صار لا يتوقف كثيراً عند مثل هذه الحوادث، بسبب انها صارت اعتيادية، وبسبب اليأس من إمكانية القضاء على هذه الظاهرة .. ويرجع ذلك إلى حزمة ضخمة من العوامل والأسباب، وهذا ليس موضوعنا الآن، ومع ذلك فقد كان للقاص ياسر عبدالباقي طريقته الخاصة في سبر غور ظاهرة الثأر، إنها طريقة الإبداع الفني الجميل في قصته القصيرة «الرأس» التي استطاع من خلالها ما لم تستطع أن تحققه أكوام من الأبحاث والدراسات، بل وحتى المشاهدة الحية لوقائع هذه الظاهرة.
لقد أتحفنا القاص ياسر عبدالباقي بقصته الرائعة الموسومة بـ «الرأس» المنشورة في العدد (4841) من صحيفة «الأيام» وهي في ظاهرها تحدثنا عن ظاهرة اجتماعية ابتلي بها المجتمع اليمني، ونعني بها ظاهرة (الثأر)، إلا أن الجديد الذي حمله لنا القاص هي طريقة عرضه لهذه الظاهرة، التي استوقفتني طويلاً، فاستمتعت بهذا العمل الإبداعي: قراءة ، وتمعناً، وتفكيراً، ودراسة.
وإذا أردنا أن نلخص قصة «الرأس» للقاص ياسر عبدالباقي، فيمكننا أن نضعها في الإطار التالي:
«إنها قصة ذلك الطفل الصغير الوحيد لوالده، الذي وضعه أبوه في سلة من القش ورماه في النهر، هروباً به من نار الثأر التي كانت مستعرة بين قبيلة والد الطفل، والقبيلة الأخرى المجاورة، فصادف أن امرأة كانت قريبة من ذلك الموقع، فأخذت الطفل وربته واعتنت به حتى صار في العشرين من عمره، وفي ذلك اليوم الذي عاود سؤاله على العجوز، لكي تخبره عن هويته الحقيقية، أخبرته بنصف الحكاية وتركت لذلك السيف الطويل القاطع أن يخبره بنصف الحكاية الآخر».
وتمتد قصة «الرأس» زمنياً نحو عشرين عاماً، وهي كامل عمر الشاب الذي «أخفاه والده في سلة من القش، ورماه في النهر» لكي يبعده من الانتقام والثأر، وكان ذلك قبل عشرين عاماً من روايته لنا قصة فقدانه رأسه بسبب الثأر ذاته.
وظاهرياً فإن قصة «الرأس» لا تشتمل إلا على شخصيتين رئيستين، ظلتا متقابلتين طوال العشرين عاماً هما:
المرأة العجوز التي أخذت الطفل من النهر، بعد أن رماه والده فيه، والتي اعتقد الصبي خطأ بأنها والدته، أما الشخصية الثانية، فهو ذلك الطفل الذي صار شاباً يقترب من العشرين ربيعاً .. إلا أن هناك العشرات، بل قل المئات من الشخصيات غير المرئية، فهناك أفراد تلكما القبيلتين، الغنية والفقيرة، بحسب قول العجوز، الذين تقاتلوا طويلاً لسبب ما، ولعله طمع إحدى تلكما القبيلتين في قهر وإخضاع القبيلة الأخرى، كما يأتي والد الطفل الذي صار شاباً، في مقدمة تلك الشخوص المكونة لقصة «الرأس».
وظاهرياً أيضاً نرى أن قصتنا هذه، وكأنها تتكون من مشهد واحد فقط ينفذه الشاب والعجوز من خلال ذلك الحوار الطويل بينهما، والذي يبدأ بقرار العجوز إخبار الشباب عن هويته الحقيقية، وروايتها له حكايته كاملة، حتى صار شاباً، ومن ثم انتهى المشهد بقطع رأس الشاب بذلك السيف القاطع الذي طالما كان يسأل عنه باستمرار. أما المشاهد الكثيرة التي لم نرها، فهي مشاهد ذلك الاقتتال الطويل والعنيف الذي حدث بين القبيلتين بسبب الثأر، فولدت ضحايا كثيرة، وأحدثت مآسي جمة، وأوجدت جبالاً من الحقد المتراكم بين الناس تجاه بعضهم البعض.
وبهدف دراستنا لهذه القصة، يمكن تقسيمها إلى ثلاثة مشاهد رئيسية:
الأول: يتمثل في فعل والد الطفل (بوضعه في سلة من القش ورميه في النهر) وقد جسد لنا القاص في هذا المشهد عدداً من الحالات الإنسانية الظاهرة والمخفية. واحدة منها، هي حالة كره ومقت وازدراء الناس المتحاربين لظاهرة الثأر، مما دفع بوالد الطفل إلى الفرار بابنه من أتون المعركة إلى مكان آخر، حتى ولو نتج عن فعله ذاك، فقدانه لولده وانقطاع أخباره عنه، كما أخبرتنا بذلك القصة، ذلك أن المهم عند الرجل، هو أن يبقى ولده حياً بعيداً عن احتراب القبيلتين.
أما الحالة الثانية، فهي حالة حب وعاطفة ملاصقة للحالة الأولى، فكراهية ذلك الأب لظاهرة الثأر، صاحبها حالة حب وعاطفة كبيرة نحو ولده الوحيد، مما حدا بالرجل إلى حماية ابنه على تلك الصورة التي أخبرتنا بها القصة، فالمهم حينها أن لا يقتل الطفل.
أما الحالة الثالثة، فهي حالة ابتهاج وفرح وانتصار، صادرة من تلك المرأة العجوز التي رأت تصرف الرجل بولده، ومن ثم أخذها للطفل، لكي تربيه وتعتني به ليصير كبيراً، برغم علمها المسبق والمتيقن، بأن هذا الطفل ليس سوى واحد من معسكر أعدائها، وذلك تأسيساً على قواعد الاحتراب القبلي، إلا أن هذه الحالة المتولدة عند المرأة، لم تكن مكتملة كلياً، بل يمكن القول إنها كانت مؤجلة إلى حين، والسبب واضح تماماً، ذلك لأن المرأة لن تستطيع تحقيق هدفها المتمثل في قتل الطفل الصغير، وكان لزاماً عليها أن تكظم حقدها حتى يكبر الطفل ويصير شاباً.
والممتع هنا في هذا المشهد، هي الصورة الفنية الجميلة التي رسمها لنا المبدع القاص ياسر عبدالباقي، من خلال تجميعه للحالات الإنسانية المتضادة في لحظة زمنية خاطفة، بدأت برمي الطفل في النهر، وانتهت بأخذه مباشرة من قبل تلك المرأة.
الثاني: ويتمثل في تربية واعتناء المرأة بالطفل حتى صار شاباً وقوياً، وقد استغرق هذا المشهد نحو عشرين عاماً، وكما هي الحال في المشهد الأول، فقد جسد لنا القاص في هذا المشهد مجموعة من الحالات الإنسانية الظاهرة والمخفية.
الحالة الأولى، تمثلت في تقمص تلك المرأة لوظيفة الأم بكل ما عليها من واجبات الأمومة نحو ذلك الولد الذي لا يمت لها بأي نوع من علاقات القرابة، بل والأدهى من ذلك، فهو - أي الولد - يمثل مشروع انتقام دفين ومؤجل بالنسبة لها، حددته سلفاً في ذلك اليوم الذي أخذته من النهر، وهو في سلته المصنوعة من القش. يتبع
لقد أتحفنا القاص ياسر عبدالباقي بقصته الرائعة الموسومة بـ «الرأس» المنشورة في العدد (4841) من صحيفة «الأيام» وهي في ظاهرها تحدثنا عن ظاهرة اجتماعية ابتلي بها المجتمع اليمني، ونعني بها ظاهرة (الثأر)، إلا أن الجديد الذي حمله لنا القاص هي طريقة عرضه لهذه الظاهرة، التي استوقفتني طويلاً، فاستمتعت بهذا العمل الإبداعي: قراءة ، وتمعناً، وتفكيراً، ودراسة.
وإذا أردنا أن نلخص قصة «الرأس» للقاص ياسر عبدالباقي، فيمكننا أن نضعها في الإطار التالي:
«إنها قصة ذلك الطفل الصغير الوحيد لوالده، الذي وضعه أبوه في سلة من القش ورماه في النهر، هروباً به من نار الثأر التي كانت مستعرة بين قبيلة والد الطفل، والقبيلة الأخرى المجاورة، فصادف أن امرأة كانت قريبة من ذلك الموقع، فأخذت الطفل وربته واعتنت به حتى صار في العشرين من عمره، وفي ذلك اليوم الذي عاود سؤاله على العجوز، لكي تخبره عن هويته الحقيقية، أخبرته بنصف الحكاية وتركت لذلك السيف الطويل القاطع أن يخبره بنصف الحكاية الآخر».
وتمتد قصة «الرأس» زمنياً نحو عشرين عاماً، وهي كامل عمر الشاب الذي «أخفاه والده في سلة من القش، ورماه في النهر» لكي يبعده من الانتقام والثأر، وكان ذلك قبل عشرين عاماً من روايته لنا قصة فقدانه رأسه بسبب الثأر ذاته.
وظاهرياً فإن قصة «الرأس» لا تشتمل إلا على شخصيتين رئيستين، ظلتا متقابلتين طوال العشرين عاماً هما:
المرأة العجوز التي أخذت الطفل من النهر، بعد أن رماه والده فيه، والتي اعتقد الصبي خطأ بأنها والدته، أما الشخصية الثانية، فهو ذلك الطفل الذي صار شاباً يقترب من العشرين ربيعاً .. إلا أن هناك العشرات، بل قل المئات من الشخصيات غير المرئية، فهناك أفراد تلكما القبيلتين، الغنية والفقيرة، بحسب قول العجوز، الذين تقاتلوا طويلاً لسبب ما، ولعله طمع إحدى تلكما القبيلتين في قهر وإخضاع القبيلة الأخرى، كما يأتي والد الطفل الذي صار شاباً، في مقدمة تلك الشخوص المكونة لقصة «الرأس».
وظاهرياً أيضاً نرى أن قصتنا هذه، وكأنها تتكون من مشهد واحد فقط ينفذه الشاب والعجوز من خلال ذلك الحوار الطويل بينهما، والذي يبدأ بقرار العجوز إخبار الشباب عن هويته الحقيقية، وروايتها له حكايته كاملة، حتى صار شاباً، ومن ثم انتهى المشهد بقطع رأس الشاب بذلك السيف القاطع الذي طالما كان يسأل عنه باستمرار. أما المشاهد الكثيرة التي لم نرها، فهي مشاهد ذلك الاقتتال الطويل والعنيف الذي حدث بين القبيلتين بسبب الثأر، فولدت ضحايا كثيرة، وأحدثت مآسي جمة، وأوجدت جبالاً من الحقد المتراكم بين الناس تجاه بعضهم البعض.
وبهدف دراستنا لهذه القصة، يمكن تقسيمها إلى ثلاثة مشاهد رئيسية:
الأول: يتمثل في فعل والد الطفل (بوضعه في سلة من القش ورميه في النهر) وقد جسد لنا القاص في هذا المشهد عدداً من الحالات الإنسانية الظاهرة والمخفية. واحدة منها، هي حالة كره ومقت وازدراء الناس المتحاربين لظاهرة الثأر، مما دفع بوالد الطفل إلى الفرار بابنه من أتون المعركة إلى مكان آخر، حتى ولو نتج عن فعله ذاك، فقدانه لولده وانقطاع أخباره عنه، كما أخبرتنا بذلك القصة، ذلك أن المهم عند الرجل، هو أن يبقى ولده حياً بعيداً عن احتراب القبيلتين.
أما الحالة الثانية، فهي حالة حب وعاطفة ملاصقة للحالة الأولى، فكراهية ذلك الأب لظاهرة الثأر، صاحبها حالة حب وعاطفة كبيرة نحو ولده الوحيد، مما حدا بالرجل إلى حماية ابنه على تلك الصورة التي أخبرتنا بها القصة، فالمهم حينها أن لا يقتل الطفل.
أما الحالة الثالثة، فهي حالة ابتهاج وفرح وانتصار، صادرة من تلك المرأة العجوز التي رأت تصرف الرجل بولده، ومن ثم أخذها للطفل، لكي تربيه وتعتني به ليصير كبيراً، برغم علمها المسبق والمتيقن، بأن هذا الطفل ليس سوى واحد من معسكر أعدائها، وذلك تأسيساً على قواعد الاحتراب القبلي، إلا أن هذه الحالة المتولدة عند المرأة، لم تكن مكتملة كلياً، بل يمكن القول إنها كانت مؤجلة إلى حين، والسبب واضح تماماً، ذلك لأن المرأة لن تستطيع تحقيق هدفها المتمثل في قتل الطفل الصغير، وكان لزاماً عليها أن تكظم حقدها حتى يكبر الطفل ويصير شاباً.
والممتع هنا في هذا المشهد، هي الصورة الفنية الجميلة التي رسمها لنا المبدع القاص ياسر عبدالباقي، من خلال تجميعه للحالات الإنسانية المتضادة في لحظة زمنية خاطفة، بدأت برمي الطفل في النهر، وانتهت بأخذه مباشرة من قبل تلك المرأة.
الثاني: ويتمثل في تربية واعتناء المرأة بالطفل حتى صار شاباً وقوياً، وقد استغرق هذا المشهد نحو عشرين عاماً، وكما هي الحال في المشهد الأول، فقد جسد لنا القاص في هذا المشهد مجموعة من الحالات الإنسانية الظاهرة والمخفية.
الحالة الأولى، تمثلت في تقمص تلك المرأة لوظيفة الأم بكل ما عليها من واجبات الأمومة نحو ذلك الولد الذي لا يمت لها بأي نوع من علاقات القرابة، بل والأدهى من ذلك، فهو - أي الولد - يمثل مشروع انتقام دفين ومؤجل بالنسبة لها، حددته سلفاً في ذلك اليوم الذي أخذته من النهر، وهو في سلته المصنوعة من القش. يتبع