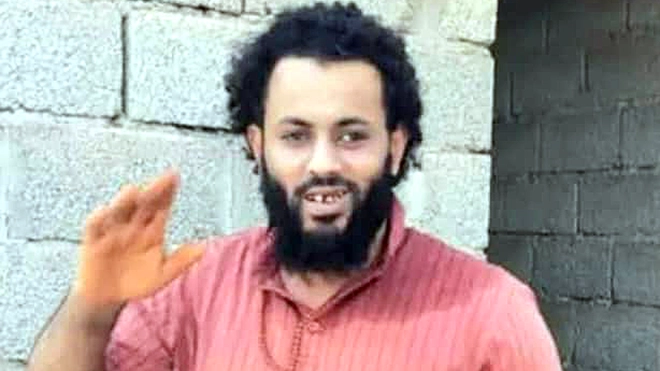> زينب البقري
(سيدة عجوز ألمانية تدخل حانة فقيرة في ألمانيا هربا من المطر، فيشعر «علي» الشاب العربي الأصل بغربتها عن المكان ومعاناتها البادية على ملامح وجهها، يتعرف عليها ويدعوها ليرقصا معا، ويخبرها في حديثهما المتبادل أن الألمان والغرب عامة هم السادة، وأن العرب تافهون دوما. هكذا بدأ فيلم «علي: الخوف يلتهم الروح» للمخرج الألماني Rainer werner fassbinder.
في الفيلم، لم يكن علي ينقل في حواره سوى الصورة المنطبعة في أذهان الغرب عن الشرق المتوحش البدائي التافه في مقابل الغرب السيد المتفوق، هذه الصورة التي ما زالت آثارها حاضرة ممتدة، كان قد عكسها جوزيف كونراد روائي الإمبراطورية البريطانية منذ عقود مضت في روايته «قلب الظلام».
فقد وصف كونراد في روايته «قلب الظلام» أفريقيا بأنها بلاد تفوح بالوحشية، تموج أدغالها بالهمجية البدائية، ورغم أنه أدان عمليات السلب والنهب التي قام بها الاستعمار في أفريقيا، فإنه لم ير في الأفارقة سوى أنوف أكثر انبساطا، وبشرة سوداء، ورجال قاسية قلوبهم، قوة حيوانية عاجزة عن صنع الحضارة، أما الأوروبي فهو الفارس البطل المرسل لتبديد الظلام ونشر الحضارة، سيجتاح بيوتهم ويسلب أراضيهم ليحقق مهمته النبيلة «أن يجعلهم أناسا متحضرين».
فعت رواية «قلب الظلام» كثيرا من الأدباء الأفارقة إلى الرد عليها، منهم الروائي النيجيري تشينوا أتشيبي، الذي رفض ما قدمه كونراد عن أفريقيا، حيث كتب روايته «الأشياء تتداعى» ليبرز ما أخفاه كونراد في «قلب الظلام». وأعلن أتشيبي قائلا: «يرضيني غاية الرضا أن تقتصر رواياتي على تعليم قرائها أن ماضيهم -بكل ما فيه من جوانب نقص- لم يكن ليلة طويلة من الوحشية».
كذلك الحال في رواية «موسم الهجرة إلى الشمال» للروائي السوداني الطيب صالح، حيث عارضت الرواية الصورة النمطية الاستشراقية عن الشرق المتخلف الوحشي. فكلٌّ من روايتي «الأشياء تتداعى» لأتشيبي و«موسم الهجرة إلى الشمال» لصالح تدور أحداثهما حول الماضي الممتد في الحاضر؛ ماضي الاستعمار وكيف غيّر في ملامح الحاضر.
لم تكن روايتا «موسم الهجرة إلى الشمال» و«الأشياء تتداعى» مجرد رد على كونراد أو دفاعا عن الشرق المستعمَر، بل مثلت رحلة بحث عن الذات بعد تجربة الاستعمار من خلال مستويين مختلفين، مستوى فردي يتمثل في رحلة مصطفى سعيد الذي سافر إلى «إنجلترا» ليدرس الاقتصاد كما جاء في رواية الطيب صالح، ومستوى جماعي آخر يأتي فيه المستعمِر ليغزو أرض قبيلة أفريقية كما عكسته رواية أتشيبي، ونرى تحولات الذات في هاتين التجربتين من خلال رؤية أخرى تختلف عن السرديات السائدة لقراءة الاستعمار المنحصرة في ثنائية الأنا والآخر، وصدام الشرق والغرب.
فثمة سعي متواصل من الدول المستعمَرة للبحث عن الذات التي كانت قبل تجربة الاستعمار، وكأن الذات ثابتة لها ملامح واحدة محددة ينبغي العودة إليها، ففي روايتي «موسم الهجرة إلى الشمال» و«الأشياء تتداعى» نرى أن تجربة الاستعمار لم تكن في صورة مقابلة بين الشرق والغرب فحسب، ولكنها تجربة تمخضت عنها ذوات جديدة للشرق والغرب معا، ذابت فيها هذه الثنائية المتناقضة، منتجة صورا جديدة.
فالوعي بهذا قد يخرجنا من حالة البحث الدائم عن ذات ما قبل الاستعمار إلى فهم الذات التي أُعيد تشكيلها، متجاوزة بذلك محاولات حصرها في ثنائيات معلبة، وهي ذاتها الثنائيات التي انشغل بها الفكر العربي على وجه الخصوص كثنائيات التراث/المعاصرة، الحداثة/التقليد، الأنا/الآخر، التخلف/التقدم، وإلخ، لندرك التجربة بشكل مختلف. ويطرح هذا سؤالا عن أوجه التلاقي بين الشرق والغرب في روايتي «الأشياء تتداعى» وموسم الهجرة إلى الشمال».

-و(الأشياء-تتداعى)-..jpg)