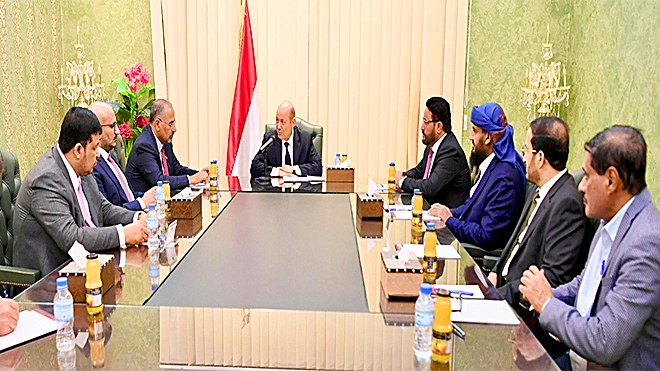> د. أحمد سنان الجابري
في أحايين كثيرة لا يستطيع المرء أن يتعرف على شخص أفقده الزمن بعض الملامح التي تعود عليها فيه.
حديثي ليس له علاقة بملامح شخص معين بذاته إلا بقدر ما يعكس ملامح مدينتي الحبيبة عدن (كريتر) كما تقولون اليوم. عدن هي الأم، ولكن ليس الأم على طريقة الأحمر، ولكن هي الأم بتعبير مجازي من حيث علاقتها ببقية المدن والمناطق المجاورة.
وحتى لا أتوه التاريخ الغابر للمدينة، أقول إن ذلك شكل ملمحاً سياسياً للمدينة، كرس سيادة مبدأ الفصل بين النفوذ السياسي والاقتصادي بحيث كل طرف قام بمهامه بصورة مثالية، الأمر الذي خلق في المدينة ازدهاراً لم يغب قط عن ملاحظة المؤرخين مثل ابن الديبع وبامخرمة وغيرهما.
عدن كان الإنسان أجمل ملامحها التي تباهت به دوماً. لم يخطر على بالي بأن يوم سيحل ولا أتعرف فيه على هذه المدينة، بل قُل إن أفتقد ملامحها البشرية، وأنه سيتم طمس هذه الملامح عنوة.
لكن الإنسان كان بالنسبة لي أهم قسمات وجه عدن البهي الطلق المفتر بابتسامة البحر وجبروت الجبل، بالإضافة إلى كل الناس الذين حفروا في وجداني وضميري نقوشاً ليست قليلة من خبراتهم ومداركهم، وهم من علموني أسلوب أنسنة الوعي، ووعي الحياة، ومترادفات الإنسان والوطن والعلم والمستقبل.

هؤلاء شكلوا إلى جانب أسرتي أسرة أخرى لي تحوي كل تناقضات المجتمع واتساقاته وكل آماله وإحباطاته.
من بين تلك العوالم البشرية يأتي الفقيد علي عبد الكريم لالجي صاحب مطبعة (الحظ). يا لذلك الانطباع الذي تحمله النفس لهذا الرجل، كان معجوناً بالطيبة والكرم والود، وربما أن كثيرين ممن كان يواسيهم لا يعرفونه. كان يجود بالعطاء على دار العجزة ومشفى الأمراض النفسية وكثير من الأسر المتعففة.
خلف البلدية كان مطعم (ديلوكس) كان الاسم يحمل في أذني رنيناً خاصاً، دائماً ما كنت أمر من أمامه وتسحرني واجهاته الزجاجية، وكثيراً ما حلمت بأن أدخله ذات يوم وأتناول فيه إحدى الوجبات. لم يتحقق الحلم طبعاً، ودارت الأيام وكف المطعم عن الوجود.
كانت الصهاريج مزاراً مهملاً على طفولتنا، ولم يكن بمقدورنا أن ندفع للحارس (كم آنة) أسبوعياً كي ندخلها، ولم يكن باستطاعتنا مثلاً تسلق الشبك المحيط بها خوفاً من الوقوع أرضاً أو بيد الحارس.

في الزمن الوحدوي لم يرَ المناضلون الوحدويون الغيورون من الصهاريج غير أنها عقار ليس له صاحب، وحان الوقت ليكون له ذلك الصاحب الجشع.
من الصعب على أي واحد أن يتخيل الميدان بدون الميدان وبدون ضحكات الأطفال وضجيجهم، بدون الدنجي وطه فريد وبدون اسم يوسف خان الذي كان ملء السمع والبصر وبدون حركة المرور المنتظمة باتجاه واحد. لكن كائنات البعد الآخر جعلت ذلك ممكناً.
طال وقوفي وتصبب العرق على كامل جسدي واشتعل وجهي احمراراً جرى الحر وطول الوقوف.
هاي جوني، قال حاتم بهائي يخاطبني، فهززت رأسي مستغرباً لعدم فهمي ما يقول وعدم توقعي أن يخرج شخص بهذا الهندام والأناقة والمكانة ليحادثني، هكذا كان تصوري لكل أصحاب المال، وفجأة يسقط تقييمي المسبق الذي بنيته بطفولية على نماذج سابقة.
من حينها كنت كل ما أمر أمام متجره إلا ويخرج لملاقاتي بندائه السالف هاي جوني.
مرت الأيام وتبدلت الظروف وجرى العمر بالرجل وأصبح متجره شبه فارغ بفعل فاعل ضميره مستتر تقديره هم.
لم يرحل حاتم وحده، بل رحلت عن عدن ملامح كثيرة أصيلة لتحل ملامح أخرى غريبة، في نظراتها وحشية وفي نفسها طمع.
كثيرون هم الناس الذين يغير الزمن ملامحهم لأسباب كثيرة، قد تكون لها علاقة بالجينات الوراثية والعوامل النفسية، وقد تكون لها علاقة بالحالة الصحية والظروف المعيشية التي مرت بساحته. لا يمكن الجزم بسبب واحد مؤثر فعلياً، وفي أحايين أخرى قد يكون السبب عائداً لخلل في الرائي نفسه وليس في الشخص المرئي. ربما بسبب ضعف الذاكرة وعدم القدرة على حفظ ملامح أو سمات شخص آخر أو أشخاص. كل هذه الاستطرادات لأنهم من حيث الرابط بين المفاهيم والأشياء مثار الحديث.
فقد كانت على الدوام مصدراً للخير لما حولها، وكما يذكر المؤرخون كان سلطان عدن لا يمارس التجارة حتى لا يجور على التجار باعتباره حاكماً وتاجراً، ولا أعرف حتى الآن هل كان ذلك بحكم منظومة القيم التي حكمت مسلكه في الإدارة، أم هي بفعل تنظيم قانوني عرفي أو مكتوب.
ولا تتميز عدن فقط بالملامح الجغرافية التي أتت عليها النهابة والزمن في تحالف غريب.
من العقبة إلى صيرة فالصهاريج هي الملامح الجغرافية التي تشكل في خاطري وفؤادي مثلثاً من الذكريات الممتزجة بخليط من الفرح والألم والجموح والسكينة، هكذا تشكلت نفسيتي منذ السنوات الأولى، وكانت المدينة هي عالمي المترامي الأطراف بين الجبل والبحر والأثر الذي يدفعنا للتأمل بإنسان الماضي ومصيره الحاضر.
كان أستاذي (محمد علي) في مدرسة عبدالناصر يفهم سيكولوجيتنا التعليمية، ويعرف أننا نختزن من المعلومات الشيء الكثير، لذلك لم يقم بامتحاننا في نهاية الفصل بالورقة المطبوعة والأسئلة والأقلام، ببساطة كان يستدعينا إلى كرسي جوار طاولته الخشبية العتيقة، ويبدأ معنا بالدردشة والحوار بين أب ناضج وابن تلمس أولى خطواته. أما الرديني سعيد فقد كان بالنسبة لنا المعلم الكامل، تعلمنا منه مبادئ اللغة العربية والدين والآداب العامة، وحتى كرة القدم التي لم أجدها قط، بسبب ضيق التنفس الذي يلازمني. والحقيقة أن كثيراً ممن علموني بدءاً من (المدير صاحب الفلكة مروراً بالقدير الفقيد عبد الله عبد الرزاق وزهرة هبة الله وكل ما بينهم يشكلون جزءاً من ملامح مدينتي).

لكن قسمات أخرى إنسانية في مدينتي افتقدتها كثيراً بحكم أن كل منهم قد جار عليه الزمن والنظم والمنافسون، هذه القسمات حفرت في نفسي عميقاً حتى أنني أحلم في بعض الهنات بأن أجلس في حضرتها وأتبادل أطراف الحديث معها.
كانت مطبعة (الحظ) بالنسبة لي جنة على الأرض، واجهتها الجميلة وبابها الأنيق، وبرودة جوها الداخلي. كنت عند دخولها لا أود الخروج، خصوصاً أن الصيف في كريتر يكون ملتهباً أي التهاب. وعند مغادرتي لم يكن يتركني أخرج خالي الوفاض دون أن يجبرني على أخذ ما ينقصني من الأدوات والأقلام وألوان، وهذا الأمر دفعني للتخفيف من زياراتي للمكتبة وأكتفي بالسلام عليه عندما ألقاه في ورشة عمي عبد الله الفقيد (فوتبات) كما كان هو وآخرون يطلقون عليه.
وتبرز (صيدلية النجم) كونها أول صيدلية في المدينة، لكن ليست الصيدلية هي مكنون النفس، ولكن الوجوه التي تعاقبت عليها وظلت على الدوام معلماً لمدينتي. لا يمكن أن أتصور عدن بدون صيدلية النجم، ولكنه حدث على الأرض ولم تعد تلك الصيدلية بارزة كالشامة على وجه المدينة، لقد دفعوها للإغلاق دفعاً كي يحلوا مكانها باستثمارهم الأكبر، ذلك ليس قانون السوق، بل قانون النفوذ حين يتزاوج المال والسلطة.
وحين تبدأ الذاكرة بتحسس المكان تجد أن معالم كثيرة وملامح قد طمست عن وجه عدن. فلم يعد أحمد دواء خانة في محله لقد بحثت عنه. في صغري علمت أنه الوحيد الذي يبيع عطر «بابوهندا» ولازالت تلك الفكرة تستوطن رأسي. ولم تحتمل نفسي أن تختفي عطورات عبد النبي الحسين أو عبد الحسين عبد النبي التي تميزت بأسمائها الرومانسية والحميمية، لكن طامة العقد الأخير من القرن الماضي جعلت ذلك ممكناً.
كانت الصهاريج كالجوهرة الخام التي لم تقع عليها عين أحد، كما أن المدينة قد ابتليت بقيادات تفتقد للجمال الداخلي الذي يحفزها على التعرف على مكامن الجمال في الطبيعة وفي الناس وإبرازه وتقديره وحمايته، فهو كما قال إيليا أبو ماضي (والذي نفسه بغير جمال **لا يرى في الوجود شيئاً جميلاً).

تمت الانتهاكات للصهاريج على مسمع ومرأى كل سلطة مرت على عدن. لم يتحرك أحد منهم مدافعاً. وإنصافاً للتاريخ تجب إزالة كل بناء حاذى أو امتد داخل أو بني في حرم الصهاريج، يجب أن يقوم الناس بذلك إذا استمرت السلطات المعنية بتجاهل الأمر.
كان نادي الحسيني ومطعم البحر الأحمر مبتدأ العالم عندي. لم يبق من ذلك شيء، فلم يعد المطعم مطعماً ولم يعد النادي نادياً. انتقل النادي إلى حضرة الجاوي عمر والعولقي سعيد، ثم إلى مجرد مبرز قات يدق الإهمال عظامه، والمطعم الذي كنت أخطط لأكون أحد زبائنه ذات يوم، وأتمكن من اختيار إحدى أسطوانات (الجرامافون) القابعة في إحدى زواياه اختفى هو الآخر. لم يقدر لي أن أدخل المطعم، ولكني كنت أحد المتفرجين الدائمين، ومؤخراً غادر العرشي صاحب المطعم عالمنا يعني لم يعد أمامي من فرصة أو أمل في عودة المطعم وتنفيذ خطتي.
أما الميدان نفسه فكان جزءاً من طفولتي، خلف عمارة يوسف خان كان يمتد ملعب ترابي وكانت فيه الكثير من ألعاب الأطفال التي تركها الوافدون المحتلون الإنجليز. ولأن الثوار لا يحبون الإنجليز ولا مخلفاتهم فقد انتقموا منهم شر انتقام فاقتلعوا الألعاب، ثم طمسوا الملعب وحولوه إلى (ستان للتاكسيات)، ثم اقتطعوا بعض أجزائه لأصحاب البلاد والدافعين بالمعروف.
طيب أيش دخل العنوان بكل ما قلته حتى الآن؟
هذه واحدة من أجمل ذكرياتي الطفولية، كان محل حاتم بهائي في طريقي نزولاً إلى سوق (الصيد)، هكذا كنا نسميه، وكذلك في طريق عودتي. كان له بابان أماميان وآخران جانبيان على الشارع الممتد أمام فندق «إحسان»، وكان أحدهما هو المدخل. كنت صغيراً حينما بدأت بتهجئة الحروف بصعوبة، ذات يوم وقفت طويلا أمام باب متجر حاتم بهائي. كان بصري مسمراً على اللوحة المعلقة فوق الباب وتحمل اسمه باللغتين العربية والإنجليزية.
خرج فجأة من داخل المتجر رجل رأيته بقياساتي حينها أنه طويل مسدول الشعر حليق الذقن أبيض البشرة بشوش الوجه، تعتلي شفتيه ابتسامة رقيقة، كان يلبس بنطلوناً أسود وقميصاً أبيض ناصعاً، تبدو كسرات المكوى ظاهرة باستقامة على القميص والبنطلون، ويلبس ربطة عنق سوداء وهو ما يعني أن «الكوت» معلق في مكان ما داخل المتجر.
ولكنني بادلته نفس الابتسامة، وشعرت نحو الرجل بود غريب، ما لفت نظري في متجر حاتم بهائي هي الدراجات الهوائية الجميلة ذات اللون الأسود والمذهب، ولكنها كانت أكبر من أن أقدر على ركوبها، لكنها متعة المشاهدة والفضول.
وكان دائماً يرد على أسئلتي الطفولية حول دراجاته وبلاد صناعتها، والسعر الذي يمكنني أن أشتري به دراجة من متجره، وكم يلزمني من الوقت لـ «أهكب» ثمن الدراجة. كان ضحوكاً ومجيباً على أسئلتي البريئة تلك. إلى الآن لا أعرف إن كانت دراجة أ. سعيد الرديني هي نفس الماركة التي كان يبيعها حاتم بهائي.
لقد شعرت بالغصة في حلقي، ودمعة كبيرة تنحدر من عيني حينما رأيت أن ذلك المتجر الأليف إلى نفسي، لم يعد كما كان، لم يعد متجراً أنيقاً للدراجات الهوائية، لقد صار (كافتيريا) تبيع العصائر والوجبات المختلفة. الحمد لله حاتم ليس هو صاحبها، ذلك الرجل الأنيق صاحب الوجه الرقيق لم يعد من ملامح عدن. سألت عنه وتقصيت الأمر، كان الجواب دوماً لقد باع حاتم بهائي بيته ومتجره وترك عدن ورحل، أو رحل ربما بسبب مذهبه أو دينه.