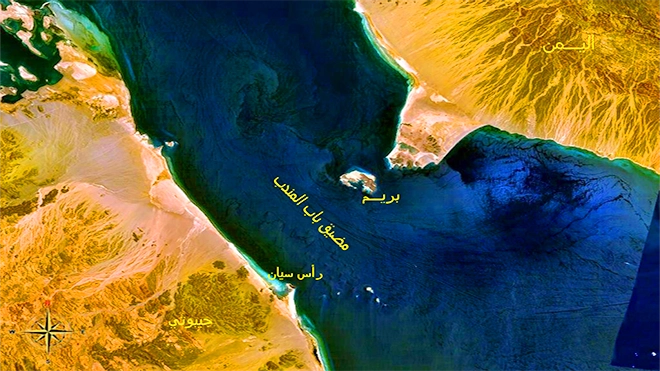> د. محمد الزغول:
يَستعدُّ النظام الرّسمي العربي لإجراء قمّتين مهمّتين في القاهرة وبغداد خلال الأيّام والأشهر المُقبِلَة؛ فبعدَ تأجيلٍ لأسبابٍ موضوعيّة ولوجستيّة، أعلنت جمهورية مصر العربية أنها سوف تستضيفُ “القمة العربية الطارئة” حول تطوُّرات القضيّة الفلسطينيّة في الرّابع من مارس الجاري في القاهرة. وفي بغداد، أعلنت وزارة الخارجية العراقيّة، اكتمالَ التحضيرات لعقد “القمة العربية” المقرّر إقامتها في بغداد هذا العام في دورتها العادية الـ34، والتي ستُعقد في الأسبوع الأول من شهر مايو المقبل.
ويأتي انعقادُ القِمّتَيْن في ظُروفٍ استثنائيّة من حيث طبيعة التطورات النّوعِيّة التي تشهدُها المنطقة؛ إذْ يواجه النظام السياسي العربي تحوّلاتٍ جوهريّة غير مسبوقة، أفرزتها متغيراتٌ إقليميّةٌ، ودوليّةٌ، بنيويّةٌ ومعقّدة، جعلت من السياسات التقليدية التي ظلّت لسنوات طويلة، ركيزةَ التّفاعُل العربي مع التحدّيات الإقليميّة والدوليّة، أدواتٍ غير ناجعةٍ في مواجهة الواقع الجيوسياسي الجديد، والمُتحوّل.
وليسَ من المُبالغة القول: إننا بإزاء لحظة مِفْصليّة، تفرضُ إعادة تعريف فلسفة العمل السياسي العربي، وفق محدّداتٍ أكثرَ تطورًا، بحيث تتجاوزُ المقاربات التقليديّة غير المُنتِجة، وتنتقلُ بالعمل العربي المشترك نحوَ سياساتٍ جماعيّةٍ ذاتِ تأثيرٍ حقيقيّ، وقادرةٍ على إعادةِ ضَبْط توازنات القُوّة الإقليمية المُنفلِتة عن عِقَالها، وفرض واقعٍ جديدٍ يرتكز إلى الندّية السياسيّة، وصياغةِ خطابٍ دبلوماسيٍّ عربيٍّ أكثر تماسُكًا، وتأثيرًا.
وقد تجلّى الوعيُ الرّسمي العربيّ بهذه الحقائق، بوضوحٍ في الموقف الأردني، خلال زيارة الملك عبدالله الثاني إلى الولايات المتحدة؛ حيثُ تم وضع الموقف الرّسمي الأردنيّ في الإطارِ العربيّ العامّ، مُستمدًّا جزءًا مهمًّا من قوّته التفاوضيّة، من مواقفِ الدول العربيّة المحوريّة، وعلى رأسِها: المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية. وذلك في محاولةٍ لتكريس نَهْجٍ قديمٍ – جديد، يقومُ على مرجعيّة القرار العربي الجماعيّ في مواجهة الضغوط الإقليمية، والدولية المتعلّقة بالقضايا العربيّة المُشترَكة. ولا شكّ أنّ إدراك الأردن العميق لحساسيّة اللّحظة التاريخيّة، وخطورة الموقف الإقليمي، هو ما يدفعه إلى ربطِ موقِفه بالقمم، والمواقف العربيّة باعتبارِها إطارًا مَرْجعيًّا، ومُلْزِمًا.
لكنّ المشهد بدأ يتغيّرُ جذريًا بعد السّابع من أكتوبر: إذْ أدّى إنهاكُ “الميليشيات” المدعومة من إيران إلى خلخلةِ مُعادلة القوّة الإقليمية، وذلك حينَ تراجعت فاعليّة “الميليشيات”، وغابت أدوارُها الإقليميّة السّابقة، لتُصبح مُجرّد قوىً محليّة، محصورةً في جغرافيّتها الضّيّقة؛ فانكفأَ “حزبُ الله” من دور المؤثّر الإقليمي في ملفات سوريا، واليمن، وفلسطين، ليصبحَ لاعبًا محليًّا، يتخندقُ ضمن الإطار اللبناني، بينما تراجعت “حماس” من كونها رأس حربةٍ في الجبهة التي كانَت تُسمّى “محور المقاومة”، إلى فاعلٍ محليٍّ فلسطينيّ، يواجه تحدّياتٍ داخليّة مُعقّدة تحت وطأة الضّربات العسكرية الإسرائيليّة. ومثلُ ذلك ينطبقُ أيضًا على “الميليشيات” في العراق، وبدرجة أقلّ على التنظيم الحوثي في اليمن، والرّاعي الإقليمي لكُلّ تلك التنظيمات في إيران.
ومِمّا يُعمِّقُ احتياج النّظام الرّسمي العربيّ لهذه المُراجعَات، بَلْ ويؤكّدُ ارتقاءَها إلى درجةٍ الضّرورة، هو الصُّعود المنهجيّ، والمُتواصل للتيّارات اليمينيّة على الجانب الإسرائيلي، وفي المشهدِ السياسيّ العالميّ بشكلٍ عامّ، وبخاصّةٍ في الولايات المتّحدة، ومُعظم الدول الأوروبيّة، وما تخلقُهُ هذه التيّارات اليمينيّة من تحدّياتٍ، وأحيانًا تهديداتٍ جوهريّة، للمصالحِ العربيّة، والأمن العربي المُشترَك. وما عادت السّياسات التقليديّة للنّظام الرّسمي العربي، والقائمة على فكرة الاحتواء، وامتصاصِ الأَثر، والمقاربات الفرديّة، والثنائيّة، وأحيانًا “المحاوريّة” فاعِلةً في مواجهة هذه التّحدّيات.
لقد كان الانشغال الشّعبي والإعلامي العربي، المُفرِط، بأطروحات التّهجير “غير الواقعيّة”، و”غير العمليّة” خلال الأسابيع الماضية، تعبيرًا عن مستويات مُتقدّمة من الشُّعور بالهشَاشة، واللّايقين. والحقيقة أنّ المجال السّياسي الفلسطيني، والعربي كانَ مدعوًّا إلى التركيز بدلًا عن ذلك، على ابتكار طُرِقٍ، ومناهجَ لاستثمار الاهتمام الدوليّ المتنامي بالقضيّة الفلسطينيّة، في وضعِ حُلولٍ، وبدائلَ، ومبادراتٍ عمليّة على طاولاتِ القرار العالميّ، تتعاملُ مع أصل الصّراع، وليس مع نتائجه اللحظيّة، وانعكاساته الإنسانيّة فقط، على أهميّتها طبعًا؛ وفي ظلّ هذا الكمّ الهائل من التضّحيات والخسائر البشريّة والماديّة التي أفرزتها الحروب الإقليمية بعد حادثة السّابع من أكتوبر، فقد بات النظام العربي برمّته أمام مسؤولية تاريخية لإبقاء فكرة “الحلّ الشامل” قائمةً، ومطروحةً، في نفس الوقت الذي ينهمكُ فيه بالتّعامل مع أطروحات المعالجة الإنسانيّة، والمُساعدات الإسعافيّة، وإعادة الإعمار.
وفي هذا السياق، ونتيجةً للوعي الرّسمي العربي المتشكّل حيال هذه المتغيّرات، برزت خلال الأسابيع والأشهر الماضية معالم تحوّل إستراتيجي في بُنية العلاقات العربية – العربية؛ حيث انتقلت من نمط التشاور البروتوكولي إلى مستوى أعلى من التماسك البنيوي، والتنسيق الإستراتيجي العابر للحدود الوطنية. وذلك في ظل إدراكٍ جماعيّ بأن التهديدات الرّاهنة، لا تستهدف مصالح جزئية، أو ملفات ثانوية، بقدر ما تمسّ جوهر النظام السياسي العربي ذاته.
وبالتوازي مع هذا التنسيق الرّسمي، يشهدُ المجال السياسي العربي، تحوّلًا آخرَ، نتجَ أيضًا عن سقوط أطروحة “محور المقاومة”، وتهاوي شعاراتها، وادّعاءاتها، تمثّل في حالة التّلاحم غير المسبوق بين النظام الرسمي العربيّ، والشارع العربي؛ حيث تشكّلت لحظة إجماع نادرة حول ضرورة رفض المشاريع المفروضة على المنطقة، وضرورة إظهار أكبر قدر ممكن من الوحدة الوطنية والتماسك الداخلي في مواجهة التحدّيات الجديدة. وعلى سبيل المثال، جاء الحراك الشعبي داخل الدول المعنيّة بمشاريع التهجير، وعلى رأسها الأردن، ومصر، داعمًا ومساندًا للموقف الرّسمي، ومُعبّرًا عن استعداد الشارع للمشاركة في تحمّل أيّ أعباء قد تنشأ عن الضغوط السياسية والاقتصادية المحتملة. وهذا التماسُك والتضامن الداخليّ، عزّز – ولا شكّ – من قدرة الدول على المناورة السياسية، كما رفعَ منسوب الثّقة الشعبيّة في القرارات السّيادية للدول.
وعلى مستوى العلاقات العربية – العربية، يعمل هذا الوعي على تصعيد مقاربة عربية جديدة، ترتكز على بناء شبكة دعم سياسية واقتصادية للدول الواقعة في دائرة الضغط، بحيث لا تظلّ هذه الدول رهينة لسياسات المساعدات المشروطة، أو الإملاءات الخارجية؛ ما يعني العمل على بلورة منظومة عربية أكثر استقلالية، تُوفّر بدائل إستراتيجية لأعضائها تعزّز مناعة القرار العربي من التدخُّلات الخارجيّة، وتمكّن الدول من التصدي للضغوط، سواء كانت سياسية أو اقتصادية، عبر تأمين مظلّة دبلوماسية واقتصادية، تمكّنها من انتهاج سياسات سيادية معقولة، ومستجيبة للمصالح الوطنية والعربية العليا، بعيدًا عن الابتزاز الدولي الذي لطالما شكّل أداة ضغط على قرارات الدول العربية.
ويأتي انعقادُ القِمّتَيْن في ظُروفٍ استثنائيّة من حيث طبيعة التطورات النّوعِيّة التي تشهدُها المنطقة؛ إذْ يواجه النظام السياسي العربي تحوّلاتٍ جوهريّة غير مسبوقة، أفرزتها متغيراتٌ إقليميّةٌ، ودوليّةٌ، بنيويّةٌ ومعقّدة، جعلت من السياسات التقليدية التي ظلّت لسنوات طويلة، ركيزةَ التّفاعُل العربي مع التحدّيات الإقليميّة والدوليّة، أدواتٍ غير ناجعةٍ في مواجهة الواقع الجيوسياسي الجديد، والمُتحوّل.
وليسَ من المُبالغة القول: إننا بإزاء لحظة مِفْصليّة، تفرضُ إعادة تعريف فلسفة العمل السياسي العربي، وفق محدّداتٍ أكثرَ تطورًا، بحيث تتجاوزُ المقاربات التقليديّة غير المُنتِجة، وتنتقلُ بالعمل العربي المشترك نحوَ سياساتٍ جماعيّةٍ ذاتِ تأثيرٍ حقيقيّ، وقادرةٍ على إعادةِ ضَبْط توازنات القُوّة الإقليمية المُنفلِتة عن عِقَالها، وفرض واقعٍ جديدٍ يرتكز إلى الندّية السياسيّة، وصياغةِ خطابٍ دبلوماسيٍّ عربيٍّ أكثر تماسُكًا، وتأثيرًا.
وقد تجلّى الوعيُ الرّسمي العربيّ بهذه الحقائق، بوضوحٍ في الموقف الأردني، خلال زيارة الملك عبدالله الثاني إلى الولايات المتحدة؛ حيثُ تم وضع الموقف الرّسمي الأردنيّ في الإطارِ العربيّ العامّ، مُستمدًّا جزءًا مهمًّا من قوّته التفاوضيّة، من مواقفِ الدول العربيّة المحوريّة، وعلى رأسِها: المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية. وذلك في محاولةٍ لتكريس نَهْجٍ قديمٍ – جديد، يقومُ على مرجعيّة القرار العربي الجماعيّ في مواجهة الضغوط الإقليمية، والدولية المتعلّقة بالقضايا العربيّة المُشترَكة. ولا شكّ أنّ إدراك الأردن العميق لحساسيّة اللّحظة التاريخيّة، وخطورة الموقف الإقليمي، هو ما يدفعه إلى ربطِ موقِفه بالقمم، والمواقف العربيّة باعتبارِها إطارًا مَرْجعيًّا، ومُلْزِمًا.
وقد كشَفت أحداث السّابع من أكتوبر، وما تلاه من ارتدادات وأحداث مأساويّة، عن حقيقةِ “قُصور الحلول المؤقّتة والمجتزأة” التي لا تُعالج الأسبابَ الجذريّة للصّراعاتِ، مثلَ: الاحتلال، والاستيطان، والحِصَار. وهناك وعيٌ رسميٌّ عربيٌّ بهذا القُصور، كشفَ عنه مقالٌ مهمّ، لمستشار رئيس دولة الإمارات للشؤون الدبلوماسية أنور قرقاش في صحيفة “الاتحاد”.
يقول قرقاش: “تعمل الدولة بالتعاون مع الأشقاء العرب والشركاء الدوليين على إيجاد حلول مستدامة تتجاوز منطق الاحتواء الذي أثبت فشله على مدار العقود الماضية، وبرغم صعوبة هذا المسار في الظروف الحاليّة، فإن الموقف الإماراتي المثابر مستمر بالتعاون مع الأشقاء العرب.”
ولم يكن الوعيُ بقصور سياسات الاحتواء المؤقّتة، هو الخلاصة الوحيدة التي خرج بها النظام العربي من خلال مُعايشة عامٍ ونيّف من الحرائق الإقليمية؛ فقد أظهرت ظروفُ ما بعد السابع من أكتوبر أيضًا، محدوديّةَ الأثر الذي يُمكن أنْ تُحدِثَهُ الدبلوماسيّةُ في سياقاتِ الصّراعات الوجوديّة، حتى وإن كانت دبلوماسيّة مُتعدّدة الأطراف؛ إذْ لم تنجح كُلُّ الجهود الدبلوماسيّة التي بُذِلت في تجنيبِ غزة مذبحةً كُبرَى، أو تجنيب المنطقة توسُّع الصّراع إلى الجغرافيا الإقليميّة.
مع ذلك، لا ينبغي إنكارُ قيمة الوساطات، والحلول المقطعيّة، مثل الوساطة المصريّة، والقطريّة في الحَرْب على غزة على سبيل المثال، والتي أدّت بالنتيجة إلى إقرار وقفٍ مؤقت لإطلاق النار. كما ينبغي تقديرُ الجهود الدبلوماسيّة الحثيثة التي بُذِلت لإيجاد نوافذ للدّعم الإنسانيّ، والإغاثةِ الفوريّة للمدنيّين، والسُّكان المُتضرّرين من المعارك في غزّة، ولبنان، وغيرهما من أماكنِ الصّراع.
ولعلّ أحد أبرز المُتغيّرات التي سيتعيّنُ على النظّام الرّسمي العربي التكيُّف معها، هو انتهاء عصر “الفاعل الميليشياوي”، وتراجُع الدّور الإيراني كقوّة إقليميّة مؤثّرة؛ فقد شهِدَ العَقْدان الماضيان صراعًا إقليميًّا بين محورين أو مشروعين مُتقابِلَيْن: محورٌ يمينيُّ متطرّفٌ على الجانب الإسرائيلي يحظى بدعمٍ أميركيّ، ومحورٌ “ميليشياويٌّ” إيرانيٌّ متطرّفٌ تمدّدَ عبرَ وكلائه في أكثر من ساحة عربيّة، وفرضَ نفسهُ فاعلًا ميدانيًّا في مختلف القضايا العربيّة.
وكان النظام العربي الرّسمي يوازنُ علاقاته مع المحورين، وبينهُما، باعتباره محور اعتدالٍ ثالثٍ. وطوال عقدين من الزمان، نجحَ النظامُ العربيّ في تقديمِ مُرافَعَتِهِ، ومُحَاجَجتِهِ السياسيّة كقوّة استقرارٍ، ومعسكرِ اعتدالٍ، ومركزِ ثِقْلٍ عَقْلانيٍّ في المنطقة والعالم، بعيدًا عن مُغامرات التّصعيد والتوتُّر التي يقودُها المحوران الآخران.
لكنّ المشهد بدأ يتغيّرُ جذريًا بعد السّابع من أكتوبر: إذْ أدّى إنهاكُ “الميليشيات” المدعومة من إيران إلى خلخلةِ مُعادلة القوّة الإقليمية، وذلك حينَ تراجعت فاعليّة “الميليشيات”، وغابت أدوارُها الإقليميّة السّابقة، لتُصبح مُجرّد قوىً محليّة، محصورةً في جغرافيّتها الضّيّقة؛ فانكفأَ “حزبُ الله” من دور المؤثّر الإقليمي في ملفات سوريا، واليمن، وفلسطين، ليصبحَ لاعبًا محليًّا، يتخندقُ ضمن الإطار اللبناني، بينما تراجعت “حماس” من كونها رأس حربةٍ في الجبهة التي كانَت تُسمّى “محور المقاومة”، إلى فاعلٍ محليٍّ فلسطينيّ، يواجه تحدّياتٍ داخليّة مُعقّدة تحت وطأة الضّربات العسكرية الإسرائيليّة. ومثلُ ذلك ينطبقُ أيضًا على “الميليشيات” في العراق، وبدرجة أقلّ على التنظيم الحوثي في اليمن، والرّاعي الإقليمي لكُلّ تلك التنظيمات في إيران.
وهذا التحوّلُ الجوهريّ، وإن كان في مجمله تحوُّلًا إيجابيًّا بالنسبة إلى النظام العربيّ، إلّا أنه لا يخلو من “العوارض الجانبيّة” الخطرة، وغير المرغوبة، ومنها: أن هذا التحوُّل أسقطَ “دور الوسيط” أو “الدور الوسطيّ” الذي كان يُمارسُهُ النظام الرسمي العربي في المُعادلة الإقليميّة، بوصفه صمّام أمان، بين قطبي التّطرُّف (اليمين إسرائيلي – الميليشيات الإيرانية). وكنتيجةٍ مباشرةٍ لتغيير هذه المعادلة، بات النظام الرسمي العربي مُضْطرًّا لمواجهة سياسات اليمين الإسرائيلي والأميركي مُباشرةً.
وبات معنيًّا بابتكار الطُّرق اللازمة للتّعامل معها، وإحباطها، كطرفٍ معنيٍّ، ومقصُودٍ بالخطابِ اليَمينيّ، وليس كصوتٍ ثالثٍ، وسطيّ وعقلانيّ، كما ظلّ عليه الحالُ طوالَ عقدَيْن من الزّمان، حينما كان الفاعلُ الإيرانيُّ “الميليشياويّ” يتولّى دور “الطّرف المُمانِعِ” في مواجهةِ المخطّطات اليَمينيّة الإسرائيليّة والأميركيّة. وبات لزامًا اليومَ، على صُنّاع القرار العربيّ، أن يعيدوا تموضعهم الإستراتيجي وفق متطلّبات المعادلة الجديدة، وأنْ يُعيدوا تعريف محدّدات الفعل السياسي المُشترَك، وفق مقارباتٍ أكثرَ ديناميكيّة، تَستَبْطِنُ إدراكًا عميقًا، وواقعيًّا لـ”توازنات القوّة”، وتستجيبُ في نفسِ الوقت، لتحدّياتِ البيئةِ الإستراتيجية في سياقاتها الجدِيدَة. ولا يمكنُ لأيٍّ من الأطرافِ العربيّة، تحمُّل تبعاتِ هذا الموقفِ الجديد مُنفرِدًا؛ ما يُحتّم على الدول العربيّة بناء سياساتٍ مشتركة، أكثر تكاملًا، وفاعليّةً.
ومِمّا يُعمِّقُ احتياج النّظام الرّسمي العربيّ لهذه المُراجعَات، بَلْ ويؤكّدُ ارتقاءَها إلى درجةٍ الضّرورة، هو الصُّعود المنهجيّ، والمُتواصل للتيّارات اليمينيّة على الجانب الإسرائيلي، وفي المشهدِ السياسيّ العالميّ بشكلٍ عامّ، وبخاصّةٍ في الولايات المتّحدة، ومُعظم الدول الأوروبيّة، وما تخلقُهُ هذه التيّارات اليمينيّة من تحدّياتٍ، وأحيانًا تهديداتٍ جوهريّة، للمصالحِ العربيّة، والأمن العربي المُشترَك. وما عادت السّياسات التقليديّة للنّظام الرّسمي العربي، والقائمة على فكرة الاحتواء، وامتصاصِ الأَثر، والمقاربات الفرديّة، والثنائيّة، وأحيانًا “المحاوريّة” فاعِلةً في مواجهة هذه التّحدّيات.
لقد كان الانشغال الشّعبي والإعلامي العربي، المُفرِط، بأطروحات التّهجير “غير الواقعيّة”، و”غير العمليّة” خلال الأسابيع الماضية، تعبيرًا عن مستويات مُتقدّمة من الشُّعور بالهشَاشة، واللّايقين. والحقيقة أنّ المجال السّياسي الفلسطيني، والعربي كانَ مدعوًّا إلى التركيز بدلًا عن ذلك، على ابتكار طُرِقٍ، ومناهجَ لاستثمار الاهتمام الدوليّ المتنامي بالقضيّة الفلسطينيّة، في وضعِ حُلولٍ، وبدائلَ، ومبادراتٍ عمليّة على طاولاتِ القرار العالميّ، تتعاملُ مع أصل الصّراع، وليس مع نتائجه اللحظيّة، وانعكاساته الإنسانيّة فقط، على أهميّتها طبعًا؛ وفي ظلّ هذا الكمّ الهائل من التضّحيات والخسائر البشريّة والماديّة التي أفرزتها الحروب الإقليمية بعد حادثة السّابع من أكتوبر، فقد بات النظام العربي برمّته أمام مسؤولية تاريخية لإبقاء فكرة “الحلّ الشامل” قائمةً، ومطروحةً، في نفس الوقت الذي ينهمكُ فيه بالتّعامل مع أطروحات المعالجة الإنسانيّة، والمُساعدات الإسعافيّة، وإعادة الإعمار.
وفي هذا السياق، ونتيجةً للوعي الرّسمي العربي المتشكّل حيال هذه المتغيّرات، برزت خلال الأسابيع والأشهر الماضية معالم تحوّل إستراتيجي في بُنية العلاقات العربية – العربية؛ حيث انتقلت من نمط التشاور البروتوكولي إلى مستوى أعلى من التماسك البنيوي، والتنسيق الإستراتيجي العابر للحدود الوطنية. وذلك في ظل إدراكٍ جماعيّ بأن التهديدات الرّاهنة، لا تستهدف مصالح جزئية، أو ملفات ثانوية، بقدر ما تمسّ جوهر النظام السياسي العربي ذاته.
وبالتوازي مع هذا التنسيق الرّسمي، يشهدُ المجال السياسي العربي، تحوّلًا آخرَ، نتجَ أيضًا عن سقوط أطروحة “محور المقاومة”، وتهاوي شعاراتها، وادّعاءاتها، تمثّل في حالة التّلاحم غير المسبوق بين النظام الرسمي العربيّ، والشارع العربي؛ حيث تشكّلت لحظة إجماع نادرة حول ضرورة رفض المشاريع المفروضة على المنطقة، وضرورة إظهار أكبر قدر ممكن من الوحدة الوطنية والتماسك الداخلي في مواجهة التحدّيات الجديدة. وعلى سبيل المثال، جاء الحراك الشعبي داخل الدول المعنيّة بمشاريع التهجير، وعلى رأسها الأردن، ومصر، داعمًا ومساندًا للموقف الرّسمي، ومُعبّرًا عن استعداد الشارع للمشاركة في تحمّل أيّ أعباء قد تنشأ عن الضغوط السياسية والاقتصادية المحتملة. وهذا التماسُك والتضامن الداخليّ، عزّز – ولا شكّ – من قدرة الدول على المناورة السياسية، كما رفعَ منسوب الثّقة الشعبيّة في القرارات السّيادية للدول.
وعلى مستوى العلاقات العربية – العربية، يعمل هذا الوعي على تصعيد مقاربة عربية جديدة، ترتكز على بناء شبكة دعم سياسية واقتصادية للدول الواقعة في دائرة الضغط، بحيث لا تظلّ هذه الدول رهينة لسياسات المساعدات المشروطة، أو الإملاءات الخارجية؛ ما يعني العمل على بلورة منظومة عربية أكثر استقلالية، تُوفّر بدائل إستراتيجية لأعضائها تعزّز مناعة القرار العربي من التدخُّلات الخارجيّة، وتمكّن الدول من التصدي للضغوط، سواء كانت سياسية أو اقتصادية، عبر تأمين مظلّة دبلوماسية واقتصادية، تمكّنها من انتهاج سياسات سيادية معقولة، ومستجيبة للمصالح الوطنية والعربية العليا، بعيدًا عن الابتزاز الدولي الذي لطالما شكّل أداة ضغط على قرارات الدول العربية.
وعلى الرغم من تقديرنا لكلّ ما سبق من إشارات، الوَعي، والتكيُّف العربيّ الرّسمي مع المتغيّرات الجوهرية في المشهدين الإقليمي والدولي؛ إلّا أن حجم المتغيّرات وأهميّتها، تتطلّبُ استجابةً بمستوىً أكثر فاعليّة ممّا تقدّمه آليات العمل العربي المشترك التقليديّة. ويعني ذلك بالضرورة، التفكير في سبلٍ لتطوير هذه الآليات، وتجديدها، وفقَ مقاربةٍ تستندُ إلى رؤية أكثر شموليّة، واستباقيّة، وأقلّ بروتوكوليةً، ورتابةً، وبيروقراطيّة. إنّها دعوة لـ”نظامٍ عربي جديد”، ليس في خريطة فاعلِيه، بل في مؤسساته، وآليات عمله، وقواعِده النّاظمة.
عن "العرب اللندنية"