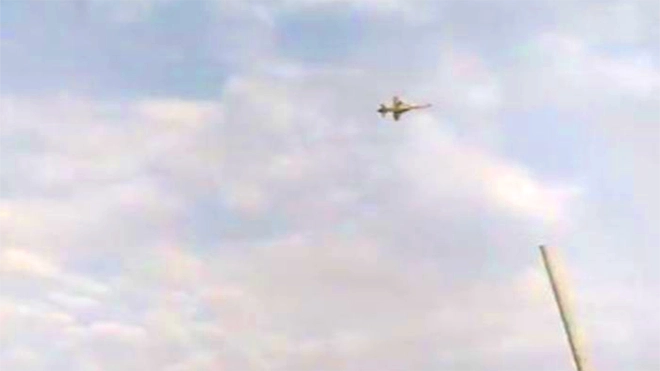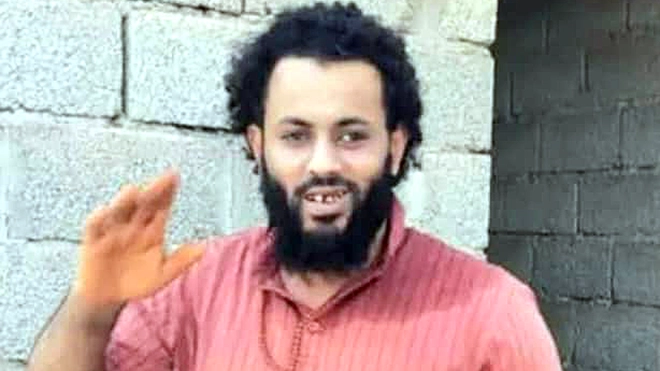> «الأيام» جلال عمر البطيلي:
ما زالت دية المرأة محل جدل وخلاف بين علماء الفقه ومذاهبه من جهة، وبين القوانين الوضعية من جهة أخرى. ولأهمية هذا الموضوع سنحاول عرض قراءتنا له بصورة مبسطة من حيث الشريعة والقوانين الوضعية في مباحث ثلاثة على النحو الآتي:
المبحث الأول وفيه ثلاثة أقسام:
القسم الأول: تعريف الدية وماهيتها
- الدية هي المال أو الضمان الذي يقدم بدلاً عن النفس أو الطرف، وسميت الأموال دية لأنها تؤدى إلى أولياء الدم. كما تسمى الدية بالعقل لأنها تعقل فيها الإبل وتقاد إلى أولياء الدم.
- وقد عرف العرب الدية وعملوا بها قبل ظهور الإسلام، وجاء الإسلام فأبقاها مع إضفاء بعض التعديلات عليها، كالمساواة في مقدار الدية بين الناس دون تفريق بين العالم والجاهل، المريض والصحيح، والقوي والضعيف حيث كان العرب يفرقون في مقدار الدية بحسب النوع والمكانة والصنف.
القسم الثاني: مشروعية الدية
- مشروعية الدية هي الكتاب والسنة النبوية والإجماع.
أولاً: الكتاب: جاءت مشروعية الدية في الكتاب في قوله تعالى:{وما كان لمؤمن أن يقتُل مؤمناً إلا خطأً، ومن قتل مؤمناً خطأً فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله} صدق الله العظيم
ثانياً: السنة: ومن السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتاباً تناول فيه الفرائض والسنن والديات، وقال في الدية «وإن في النفس مائة من الإبل».
ثالثاً: الإجماع: أما الإجماع فقد روي وتنوقل أن الصحابة عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ساروا على ذلك فكان إجماعاً.
القسم الثالث: الحكمة من مشروعية الدية
شرعت الدية لأكثر من سبب كان أظهرها هو الردع والزجر، واحترام النفس الآدمية وعدم إهدارها، كما أنها بمثابة تعويض عن آلام النفس وإرضاء للمجني عليه أو وليه وورثته من بعده، كما مثلت الدية التطبيق العملي للقاعدة الفقهية (لا يهدر دم في الإسلام) حيث من غير الصحيح أن يعاقب أو يقتص من شخص لفعل صدر خطأ عنه ولم يقصده، وإنما يرفع عنه الخطأ هنا استثناء، وكذلك القصاص في شبه العمد يستبعد لعدم المقدرة على تحقيق المماثلة فيه. لهذا كان وفي المقابل من ذلك وجوب احترام النفس الآدمية وعدم ترك المجني عليه هكذا وإنما شرعت له الدية كتعويض له وجزاء للفاعل في آن واحد.. لذلك كانت الدية جامعة بين العقوبة والتعويض.
المبحث الثاني وفيه ثلاثة أقسام:
القسم الأول: حالات وجوب الدية
الأصل أن الدية شرعة للفعل الخطأ، والأصل أيضاً أن الدية هي عقوبة وليست تعويضا. ومنه فإن للدية حالة واحدة تكون فيها واجبة وأصلية وهي في الخطأ. وهناك استثناء وهو أن تكون الدية عقوبة بديلة وليست أصلية، كما في الفعل العمد. ومنه فإن للدية حالتين إما أن تكون أصلية وإما أن تكون بديلة.
الحالة الأولى: الدية كعقوبة أصلية
وتكون الدية عقوبة أصلية في حال كون الفعل الموجب للعقوبة خطأ - أكان إزهاق الروح أو جروحاً أو ذهاب وهلاك الأطرف وما دون النفس - فهنا تكون العقوبة الأصلية والوحيدة هي الدية وذلك ثابت بالنص القرآني لقوله تعالى: {ومن قتل مؤمناً خطأً فدية مسلمة إلى أهله..} ويدخل في ذلك الجروح وهلاك الأطراف وما دون النفس من باب أولى.
الحالة الثانية: الدية كعقوبة بديلة
وتكون الدية عقوبة بديلة وليست أصلية في أكثر من حالة، وهي عندما يكون الفعل الموجب للعقوبة عمداً - أكان قتلاً (إزهاق الروح) أو جروحاً أو ذهاب الأطراف - وكذلك تكون الدية عقوبة بديلة في شبه العمد - أكان الفعل وقع على النفس أو ما دونها من الأطراف أو الجروح - أي بمعنى أوضح أن الدية تكون عقوبة بديلة في حالتين هما: العمد وشبه العمد لأن الأصل في هاتين الحالتين هو القصاص وليس الدية وذلك لقوله تعالى: {وكتبنا عليهم فيها أن النفسَ بالنفس والعينَ بالعين والأنفَ بالأنف والأُذُنَ بالأُذُن والسنَّ بالسن والجروحَ قصاص...} صدق الله العظيم. وهنا كما في القتل العمد تكون الدية عقوبة بديلة للقصاص وليست أصلية ولكن بشروط هي إما تنازل أولياء الدم عن القصاص وقبول الدية بدلاً عنه، وإما عدم توافر شروط القصاص كأن يكون الفاعل قاصراً أو مختلاً عقلياً وغيرها من الشروط التي يسقط القصاص بوجودها، هذا في القتل العمد، أما في شبه العمد وما دون النفس والجروح فيسقط فيها القصاص لوجود شبهة عدم المقدرة على المماثلة وتحل الدية محلاً للقصاص في هاتين الحالتين.
علماً بأن هناك خلافاً في هذا الموضوع بين المذهبين المالكي والشافعي من حيث تقسيم الفعل الموجب للعقوبة.. فالمالكية هم من يقسمون الفعل إلى عمد وخطأ ولا يعرفون شبه العمد، على خلاف الشافعية الذين يقسمون الفعل الموجب للعقاب إلى عمد وشبه عمد وخطأ. وقد أخذ المشرع اليمني في تقسيم الجريمة بالمذهب الشافعي فكانت عمد وشبه عمد وخطأ، وجعل الدية عقوبة بديلة في حالة العمد وشبه العمد، وأصلية في حال الخطأ.
القسم الثاني: صور الدية من حيث مقدارها وأنواعها:
أولاً: الدية من حيث مقدارها: للدية من حيث مقدارها صورتان:
الصورة الأولى: دية كاملة
وتكون في حال ذهاب النفس أو ما كان منه عضواً أو اثنين أو أكثر مما دون النفس من الأعضاء كالأنف والذكر والأذن والعين وغيرها، ويكون ذلك في حال كون الفعل عمداً أو شبه عمد، وفي حالة العمد يشترط تنازل أولياء الدم أو عدم توافر شروط القصاص، أما حالة شبه العمد فيكون ذلك لعدم إمكانية تحقق المماثلة في القصاص، وهناك تكون الدية كاملة ومغلظة حسب مذهب الشافعية، بينما خالفهم المالكية الذين يعتبرون الدية في العمد هي ما تصالح عليه الأطراف كثر أم قل حسب رأي المالكية باعتبار أنهم يعتبرون الدية في العمد وشبه العمد صلحاً وليست عقوبة، لعدم وجود شبه العمد في تقسيمهم للجريمة.
الصورة الثانية: دية غير كاملة أو إرش
وهي ما يرد على ما دون النفس من الأعضاء كالأنف والأذن والعين وغيرها بشرط عدم ذهابها كاملة أو ذهاب منافعها وجمالها. وتكون هنا الدية ناقصة وغير كاملة وإن كان الفعل عمداً أو شبه عمد وينقص منها (أي من الدية) هنا بقدر ما بقي من هذه الأعضاء أو منافعها. كأن تفوت عين وتبقى الأخرى فينقص من الدية النصف (قيمة العين الأخرى).. والعلة هنا في عدم إقامة القصاص واستبداله بالدية كما أوضحنا هو شبهة عدم المقدرة على تحقيق المماثلة في القصاص.
أما بالنسبة للخطأ أي القتل أو الفعل الخطأ فإنه يدخل ضمن الدية غير الكاملة استثناء من المشرع بنص صريح إذا أنقص الخُمس من الدية في الخطأ فكانت ضمن الدية غير الكاملة استثناء وإن كان الفعل يتوجب الدية الكاملة، إلا أن النقص كان استثناء بنص قانوني.
ثانياً: الدية من حيث أنواعها: وهي نوعان:
1- الدية المغلظة
اتفق الفقهاء على أن الدية المغلّظة هي ما تجب في القتل شبه العمد، وقد خرج عن ذلك المالكية لعدم اشتمال تقسيمهم للجريمة على شبه العمد. ومعنى مغلّظة هي مائة من الإبل في بطون أربعين منها أولادها.
2- الدية المخففة
وكذلك الحال بالنسبة للدية المخففة اتفق الفقهاء على أنها هي ما تجب في القتل الخطأ.. ومع اتفاق الفقهاء في شبه العمد والخطأ من حيث تغليظ الدية وتخفيفها إلا أنهم اختلفوا في القتل العمد.. فالشافعية يرون تغليظ الدية في القتل العمد، وخالفهم الحنفية والمالكية في عدم تغليظ دية العمد واعتماد ما تصالح عليه الأطراف. كما أن للمذهب الشافعي رأياً في تغليظ الدية في الجروح أيضاً وذلك في الأشهر الحرم وعلى ذوي الأرحام وخالفهم في ذلك الحنفية. ونحن نتفق مع الحنفية والمالكية في عدم تغليظ دية العمد باعتبار الدية هنا ليست عقوبة أصلية وإنما هي بديلة للقصاص وموقوفة على رضا أولياء الدم وما تصالحوا عليه.
القسم الثالث: على من تجب الدية وما مقدارها؟
أولاً: مقدار الدية
الدية هي مقدار معين من المال، وهي بذلك تكون عقوبة إلا أنها تدخل في مال المجني عليه وليس في خزانة الدولة. وبذلك تكون الدية ذات طبيعة مزدوجة. فهي عقوبة وتعويض في الوقت نفسه، إلا أن ذلك لا يعني أن الدية هي تعويض صرف بل هي عقوبة جنائية مقررة وثابتة كجزاء للجريمة، ولا يتوقف الحكم بها على طلب الأفراد، ولا يدخل فيها تعويضات الضرر.
- أما مقدار الدية فهو مائة رأس من الإبل وفقاً لتقديرات الشريعة الإسلامية والثابتة بحديث رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بقوله: «وأن في النفس مائة من الإبل»، وقد خالفها في ذلك القوانين الوضعية ومنها القانون اليمني حيث قدر الدية بألف مثقال من الذهب، أو خمسمائة جنيه من الذهب أبو ولد وما يعادلهما من العملة الورقية بسعر وقت التنفيذ. وذلك ما تناوله نص المادة (40) من قانون العقوبات اليمني رقم (12) لعام 94م والتي عدلت بالقرار رقم (16) لعام 95م ليصبح مقدار الدية بذلك سبعمائة ألف ريال يمني.
- ومن الملاحظ هنا أن المشرع اليمني وبعض التشريعات الوضعية الأخرى قد جافت إلى حد كبير أحكام الشريعة الإسلامية في تحديد مقدار الدية وخالفتها إلا أن ذلك وكما يحمل مخالفة للشريعة ومضار في حالات فإنه يحمل أيضاً منافع في حالات أخرى- كما في القتل الخطأ الذي اتفق الفقهاء على تخفيف الدية فيه - والتي يكون فيها أمر مغالاة الدية ضرراً بالأفراد المتسببين في ذلك بالخطأ، كأن ينقلب شخص وهو نائم على شخص آخر فيقتله دون أن يقصد ذلك فإن المغالاة في تحميله الدية يكون فيها ضرر وكذلك الحال للحوادث المرورية وغيرها مما لا يكون لصاحبها يد فيها وتخرج عن إرادته. فإن المغالاة في الدية في هذه الحالات قد لا تكون مجدية بقدر ما تتركه من إثقال لكاهل الفرد الذي لا يد له في هذا الفعل ولم يقصده وكان خارجاً عن إرادته (ولعل اجتهاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في وقف حد السرقة في عام المجاعة يشفع للمشرع اليمني ذلك إذا ما قسناه عليه).
ثانياً: على من تجب الدية؟
الأصل أن تجب الدية على الجاني ومن ماله الخاص، لأنه من ارتكب الجريمة وهو من عليه أن يتحمل تبعاتها. غير أن هناك حالات تحمل العاقلة فيها الدية وحالات تحمل جزءا منها وبيان ذلك على النحو الأتي:
أولاً: حالات تحمل الجاني للدية
تكون الدية في مال الجاني في حالات:
أ- القتل العمد: وتكون الدية من مال الجاني في القتل العمد بشروط هي عدم توافر شروط القصاص أو التنازل عنه ممن يملكه مقابل الدية. فتكون الدية هنا من مال الجاني وحدة.
ب- التصالح: كأن يدخل الجاني في صلح على القصاص وبدلاً عنه بأكثر أو أقل من الدية. فهنا أيضاً تكون الدية من مال الجاني وحده دون أن تتحمل معه العاقلة شيئاً منها.
ج- الإقرار: أي إقرار الجاني، لأن الإقرار حجة عليه دون غيره فتكون الدية من ماله دون غيره.
ثانياً: حالات تحمل المباشر للدية
ويكون ذلك في حال اجتماع أكثر من شخص على قتل المجني عليه، بحيث تقدم أحدهم وباشر الفعل، فتكون الدية هنا على المباشر دون الآخرين إلا إذا أحدثوا جروحاً فيحمل هو الدية وهم الإرش.
ثالثاً: حالات تحمل العاقلة للدية ومشروعيتها
العاقلة هي عصبة الجاني البالغون العاقلون الموافقون في الدين، ويخرج منهم أبناء الجاني والزوج. ويدخل في مسمى العاقلة أيضاً الدولة وبيت المال في حال ليس للجاني عاقلة عصبة أو لا يستطيعون الوفاء بأنصابهم من الدية. وبالنسبة لابن الزنا (لا عصبة له) فإن عاقلته هي عواقل أمه.
والعاقلة تتحمل الدية في حالات هي:
شبه العمد والخطأ فقط وبمقدار الثلثين من الدية ولا تدخل في العمد، إذ في هذه الحالة يتحمل الدية الجاني نفسه، كما أن مسؤولية العاقلة في تحمل جزء من الدية يسقط أيضاً في حال ثبوت الجريمة بصلح أو باعتراف الجاني - فهنا تسقط مسؤولية العاقلة - كما تتحمل العاقلة (الدولة) الدية كامل في حالة أن لا يكون للجاني عاقلة أو أنهم معدمون. وقد أخذ المشرع اليمني بهذا الاتجاه فيما يتعلق بمن يتحمل الدية ومقدارها ومسؤولية العاقلة فيها وذلك ما تناوله صراحة في نصوص المواد (27-99) عقوبات نافذ.
مشروعية تحمل العاقلة للدية وأسبابها
إن مشروعية تحمل العاقلة لجزء من الدية أو الدية كاملة هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة رمت أخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها.
ولعل سبب إشراك العاقلة في تحمل الدية هو العمل على إحداث الوقاية من الجريمة والحد منها من خلال حمل العاقلة على توجيه أفرادها على السلوك القويم الذي يجنب الوقوع في الخطأ لما يترتب على ذلك من إشراكها في المسؤولية وتحملها جزءاً منها.
المبحث الأول وفيه ثلاثة أقسام:
القسم الأول: تعريف الدية وماهيتها
- الدية هي المال أو الضمان الذي يقدم بدلاً عن النفس أو الطرف، وسميت الأموال دية لأنها تؤدى إلى أولياء الدم. كما تسمى الدية بالعقل لأنها تعقل فيها الإبل وتقاد إلى أولياء الدم.
- وقد عرف العرب الدية وعملوا بها قبل ظهور الإسلام، وجاء الإسلام فأبقاها مع إضفاء بعض التعديلات عليها، كالمساواة في مقدار الدية بين الناس دون تفريق بين العالم والجاهل، المريض والصحيح، والقوي والضعيف حيث كان العرب يفرقون في مقدار الدية بحسب النوع والمكانة والصنف.
القسم الثاني: مشروعية الدية
- مشروعية الدية هي الكتاب والسنة النبوية والإجماع.
أولاً: الكتاب: جاءت مشروعية الدية في الكتاب في قوله تعالى:{وما كان لمؤمن أن يقتُل مؤمناً إلا خطأً، ومن قتل مؤمناً خطأً فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله} صدق الله العظيم
ثانياً: السنة: ومن السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتاباً تناول فيه الفرائض والسنن والديات، وقال في الدية «وإن في النفس مائة من الإبل».
ثالثاً: الإجماع: أما الإجماع فقد روي وتنوقل أن الصحابة عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ساروا على ذلك فكان إجماعاً.
القسم الثالث: الحكمة من مشروعية الدية
شرعت الدية لأكثر من سبب كان أظهرها هو الردع والزجر، واحترام النفس الآدمية وعدم إهدارها، كما أنها بمثابة تعويض عن آلام النفس وإرضاء للمجني عليه أو وليه وورثته من بعده، كما مثلت الدية التطبيق العملي للقاعدة الفقهية (لا يهدر دم في الإسلام) حيث من غير الصحيح أن يعاقب أو يقتص من شخص لفعل صدر خطأ عنه ولم يقصده، وإنما يرفع عنه الخطأ هنا استثناء، وكذلك القصاص في شبه العمد يستبعد لعدم المقدرة على تحقيق المماثلة فيه. لهذا كان وفي المقابل من ذلك وجوب احترام النفس الآدمية وعدم ترك المجني عليه هكذا وإنما شرعت له الدية كتعويض له وجزاء للفاعل في آن واحد.. لذلك كانت الدية جامعة بين العقوبة والتعويض.
المبحث الثاني وفيه ثلاثة أقسام:
القسم الأول: حالات وجوب الدية
الأصل أن الدية شرعة للفعل الخطأ، والأصل أيضاً أن الدية هي عقوبة وليست تعويضا. ومنه فإن للدية حالة واحدة تكون فيها واجبة وأصلية وهي في الخطأ. وهناك استثناء وهو أن تكون الدية عقوبة بديلة وليست أصلية، كما في الفعل العمد. ومنه فإن للدية حالتين إما أن تكون أصلية وإما أن تكون بديلة.
الحالة الأولى: الدية كعقوبة أصلية
وتكون الدية عقوبة أصلية في حال كون الفعل الموجب للعقوبة خطأ - أكان إزهاق الروح أو جروحاً أو ذهاب وهلاك الأطرف وما دون النفس - فهنا تكون العقوبة الأصلية والوحيدة هي الدية وذلك ثابت بالنص القرآني لقوله تعالى: {ومن قتل مؤمناً خطأً فدية مسلمة إلى أهله..} ويدخل في ذلك الجروح وهلاك الأطراف وما دون النفس من باب أولى.
الحالة الثانية: الدية كعقوبة بديلة
وتكون الدية عقوبة بديلة وليست أصلية في أكثر من حالة، وهي عندما يكون الفعل الموجب للعقوبة عمداً - أكان قتلاً (إزهاق الروح) أو جروحاً أو ذهاب الأطراف - وكذلك تكون الدية عقوبة بديلة في شبه العمد - أكان الفعل وقع على النفس أو ما دونها من الأطراف أو الجروح - أي بمعنى أوضح أن الدية تكون عقوبة بديلة في حالتين هما: العمد وشبه العمد لأن الأصل في هاتين الحالتين هو القصاص وليس الدية وذلك لقوله تعالى: {وكتبنا عليهم فيها أن النفسَ بالنفس والعينَ بالعين والأنفَ بالأنف والأُذُنَ بالأُذُن والسنَّ بالسن والجروحَ قصاص...} صدق الله العظيم. وهنا كما في القتل العمد تكون الدية عقوبة بديلة للقصاص وليست أصلية ولكن بشروط هي إما تنازل أولياء الدم عن القصاص وقبول الدية بدلاً عنه، وإما عدم توافر شروط القصاص كأن يكون الفاعل قاصراً أو مختلاً عقلياً وغيرها من الشروط التي يسقط القصاص بوجودها، هذا في القتل العمد، أما في شبه العمد وما دون النفس والجروح فيسقط فيها القصاص لوجود شبهة عدم المقدرة على المماثلة وتحل الدية محلاً للقصاص في هاتين الحالتين.
علماً بأن هناك خلافاً في هذا الموضوع بين المذهبين المالكي والشافعي من حيث تقسيم الفعل الموجب للعقوبة.. فالمالكية هم من يقسمون الفعل إلى عمد وخطأ ولا يعرفون شبه العمد، على خلاف الشافعية الذين يقسمون الفعل الموجب للعقاب إلى عمد وشبه عمد وخطأ. وقد أخذ المشرع اليمني في تقسيم الجريمة بالمذهب الشافعي فكانت عمد وشبه عمد وخطأ، وجعل الدية عقوبة بديلة في حالة العمد وشبه العمد، وأصلية في حال الخطأ.
القسم الثاني: صور الدية من حيث مقدارها وأنواعها:
أولاً: الدية من حيث مقدارها: للدية من حيث مقدارها صورتان:
الصورة الأولى: دية كاملة
وتكون في حال ذهاب النفس أو ما كان منه عضواً أو اثنين أو أكثر مما دون النفس من الأعضاء كالأنف والذكر والأذن والعين وغيرها، ويكون ذلك في حال كون الفعل عمداً أو شبه عمد، وفي حالة العمد يشترط تنازل أولياء الدم أو عدم توافر شروط القصاص، أما حالة شبه العمد فيكون ذلك لعدم إمكانية تحقق المماثلة في القصاص، وهناك تكون الدية كاملة ومغلظة حسب مذهب الشافعية، بينما خالفهم المالكية الذين يعتبرون الدية في العمد هي ما تصالح عليه الأطراف كثر أم قل حسب رأي المالكية باعتبار أنهم يعتبرون الدية في العمد وشبه العمد صلحاً وليست عقوبة، لعدم وجود شبه العمد في تقسيمهم للجريمة.
الصورة الثانية: دية غير كاملة أو إرش
وهي ما يرد على ما دون النفس من الأعضاء كالأنف والأذن والعين وغيرها بشرط عدم ذهابها كاملة أو ذهاب منافعها وجمالها. وتكون هنا الدية ناقصة وغير كاملة وإن كان الفعل عمداً أو شبه عمد وينقص منها (أي من الدية) هنا بقدر ما بقي من هذه الأعضاء أو منافعها. كأن تفوت عين وتبقى الأخرى فينقص من الدية النصف (قيمة العين الأخرى).. والعلة هنا في عدم إقامة القصاص واستبداله بالدية كما أوضحنا هو شبهة عدم المقدرة على تحقيق المماثلة في القصاص.
أما بالنسبة للخطأ أي القتل أو الفعل الخطأ فإنه يدخل ضمن الدية غير الكاملة استثناء من المشرع بنص صريح إذا أنقص الخُمس من الدية في الخطأ فكانت ضمن الدية غير الكاملة استثناء وإن كان الفعل يتوجب الدية الكاملة، إلا أن النقص كان استثناء بنص قانوني.
ثانياً: الدية من حيث أنواعها: وهي نوعان:
1- الدية المغلظة
اتفق الفقهاء على أن الدية المغلّظة هي ما تجب في القتل شبه العمد، وقد خرج عن ذلك المالكية لعدم اشتمال تقسيمهم للجريمة على شبه العمد. ومعنى مغلّظة هي مائة من الإبل في بطون أربعين منها أولادها.
2- الدية المخففة
وكذلك الحال بالنسبة للدية المخففة اتفق الفقهاء على أنها هي ما تجب في القتل الخطأ.. ومع اتفاق الفقهاء في شبه العمد والخطأ من حيث تغليظ الدية وتخفيفها إلا أنهم اختلفوا في القتل العمد.. فالشافعية يرون تغليظ الدية في القتل العمد، وخالفهم الحنفية والمالكية في عدم تغليظ دية العمد واعتماد ما تصالح عليه الأطراف. كما أن للمذهب الشافعي رأياً في تغليظ الدية في الجروح أيضاً وذلك في الأشهر الحرم وعلى ذوي الأرحام وخالفهم في ذلك الحنفية. ونحن نتفق مع الحنفية والمالكية في عدم تغليظ دية العمد باعتبار الدية هنا ليست عقوبة أصلية وإنما هي بديلة للقصاص وموقوفة على رضا أولياء الدم وما تصالحوا عليه.
القسم الثالث: على من تجب الدية وما مقدارها؟
أولاً: مقدار الدية
الدية هي مقدار معين من المال، وهي بذلك تكون عقوبة إلا أنها تدخل في مال المجني عليه وليس في خزانة الدولة. وبذلك تكون الدية ذات طبيعة مزدوجة. فهي عقوبة وتعويض في الوقت نفسه، إلا أن ذلك لا يعني أن الدية هي تعويض صرف بل هي عقوبة جنائية مقررة وثابتة كجزاء للجريمة، ولا يتوقف الحكم بها على طلب الأفراد، ولا يدخل فيها تعويضات الضرر.
- أما مقدار الدية فهو مائة رأس من الإبل وفقاً لتقديرات الشريعة الإسلامية والثابتة بحديث رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بقوله: «وأن في النفس مائة من الإبل»، وقد خالفها في ذلك القوانين الوضعية ومنها القانون اليمني حيث قدر الدية بألف مثقال من الذهب، أو خمسمائة جنيه من الذهب أبو ولد وما يعادلهما من العملة الورقية بسعر وقت التنفيذ. وذلك ما تناوله نص المادة (40) من قانون العقوبات اليمني رقم (12) لعام 94م والتي عدلت بالقرار رقم (16) لعام 95م ليصبح مقدار الدية بذلك سبعمائة ألف ريال يمني.
- ومن الملاحظ هنا أن المشرع اليمني وبعض التشريعات الوضعية الأخرى قد جافت إلى حد كبير أحكام الشريعة الإسلامية في تحديد مقدار الدية وخالفتها إلا أن ذلك وكما يحمل مخالفة للشريعة ومضار في حالات فإنه يحمل أيضاً منافع في حالات أخرى- كما في القتل الخطأ الذي اتفق الفقهاء على تخفيف الدية فيه - والتي يكون فيها أمر مغالاة الدية ضرراً بالأفراد المتسببين في ذلك بالخطأ، كأن ينقلب شخص وهو نائم على شخص آخر فيقتله دون أن يقصد ذلك فإن المغالاة في تحميله الدية يكون فيها ضرر وكذلك الحال للحوادث المرورية وغيرها مما لا يكون لصاحبها يد فيها وتخرج عن إرادته. فإن المغالاة في الدية في هذه الحالات قد لا تكون مجدية بقدر ما تتركه من إثقال لكاهل الفرد الذي لا يد له في هذا الفعل ولم يقصده وكان خارجاً عن إرادته (ولعل اجتهاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في وقف حد السرقة في عام المجاعة يشفع للمشرع اليمني ذلك إذا ما قسناه عليه).
ثانياً: على من تجب الدية؟
الأصل أن تجب الدية على الجاني ومن ماله الخاص، لأنه من ارتكب الجريمة وهو من عليه أن يتحمل تبعاتها. غير أن هناك حالات تحمل العاقلة فيها الدية وحالات تحمل جزءا منها وبيان ذلك على النحو الأتي:
أولاً: حالات تحمل الجاني للدية
تكون الدية في مال الجاني في حالات:
أ- القتل العمد: وتكون الدية من مال الجاني في القتل العمد بشروط هي عدم توافر شروط القصاص أو التنازل عنه ممن يملكه مقابل الدية. فتكون الدية هنا من مال الجاني وحدة.
ب- التصالح: كأن يدخل الجاني في صلح على القصاص وبدلاً عنه بأكثر أو أقل من الدية. فهنا أيضاً تكون الدية من مال الجاني وحده دون أن تتحمل معه العاقلة شيئاً منها.
ج- الإقرار: أي إقرار الجاني، لأن الإقرار حجة عليه دون غيره فتكون الدية من ماله دون غيره.
ثانياً: حالات تحمل المباشر للدية
ويكون ذلك في حال اجتماع أكثر من شخص على قتل المجني عليه، بحيث تقدم أحدهم وباشر الفعل، فتكون الدية هنا على المباشر دون الآخرين إلا إذا أحدثوا جروحاً فيحمل هو الدية وهم الإرش.
ثالثاً: حالات تحمل العاقلة للدية ومشروعيتها
العاقلة هي عصبة الجاني البالغون العاقلون الموافقون في الدين، ويخرج منهم أبناء الجاني والزوج. ويدخل في مسمى العاقلة أيضاً الدولة وبيت المال في حال ليس للجاني عاقلة عصبة أو لا يستطيعون الوفاء بأنصابهم من الدية. وبالنسبة لابن الزنا (لا عصبة له) فإن عاقلته هي عواقل أمه.
والعاقلة تتحمل الدية في حالات هي:
شبه العمد والخطأ فقط وبمقدار الثلثين من الدية ولا تدخل في العمد، إذ في هذه الحالة يتحمل الدية الجاني نفسه، كما أن مسؤولية العاقلة في تحمل جزء من الدية يسقط أيضاً في حال ثبوت الجريمة بصلح أو باعتراف الجاني - فهنا تسقط مسؤولية العاقلة - كما تتحمل العاقلة (الدولة) الدية كامل في حالة أن لا يكون للجاني عاقلة أو أنهم معدمون. وقد أخذ المشرع اليمني بهذا الاتجاه فيما يتعلق بمن يتحمل الدية ومقدارها ومسؤولية العاقلة فيها وذلك ما تناوله صراحة في نصوص المواد (27-99) عقوبات نافذ.
مشروعية تحمل العاقلة للدية وأسبابها
إن مشروعية تحمل العاقلة لجزء من الدية أو الدية كاملة هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة رمت أخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها.
ولعل سبب إشراك العاقلة في تحمل الدية هو العمل على إحداث الوقاية من الجريمة والحد منها من خلال حمل العاقلة على توجيه أفرادها على السلوك القويم الذي يجنب الوقوع في الخطأ لما يترتب على ذلك من إشراكها في المسؤولية وتحملها جزءاً منها.