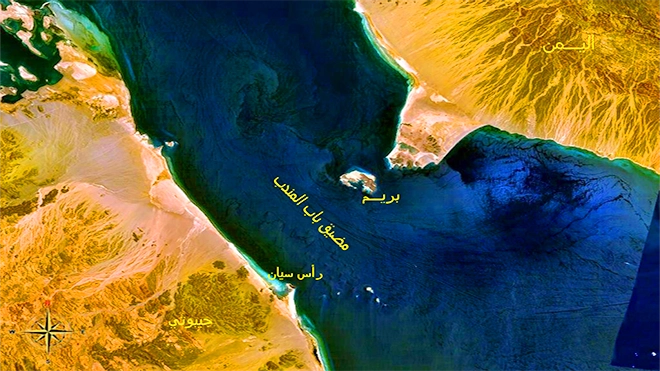بات مؤكدًا ومن المسلم به أيضًا وعبر محطات التاريخ المختلفة، بأن الاعتماد على الرؤى الشاملة والأفعال الوطنية الناضجة والمسؤولة فقط، تتحقق الأهداف الكبرى للشعوب، وشعبنا وقضيته الوطنية ليس استثناء أو خارج هذه المعادلة الحاكمة، وبغير ذلك ستبقى بعض آمالنا وأهدافنا تراوح مكانها، ولن تحققها الخطابات الوطنية مهما بلغ صدقها ووضوحها وشجاعة رجالها، ولن ننالها عبر التغني اليومي بالشعارات التي لا تجد لها حضورًا فاعلًا في إيقاع الحياة اليومية للناس، مالم يتجسد كل ذلك عمليًا بالفعل الواعي والمنظم على الأرض.
ووفقًا لرؤية وطنية وسياسية عميقة وشاملة، وتخضع للمراجعة الفاحصة بين وقت وآخر وحسب مقتضيات الظروف، وأن تأخذ دومًا بعين الاعتبار كل تفاعلات المشهد التاريخي القائم داخليًا وخارجيًا، وبكل أبعاده الماثلة والمحتملة كذلك سلبًا وإيجابًا، وما ينبغي فعله إزاء كل ذلك وبوعي كامل وبمسؤولية وطنية عالية.
كما يتطلب ذلك الابتعاد عن العشوائية وحالات التفاعل الآنية غير المدروسة، وردود الأفعال الغاضبة، التي عادة ما تجانب الصواب، وتجعل من الأخطاء غير المقصودة على الأقل أمرًا واردًا، وتبعث برسائل سلبية لأكثر من طرف وفي وقت واحد، وحينها لا قيمة للندم بعد أن يكون قد وقع الفأس على الرأس كما يقال.