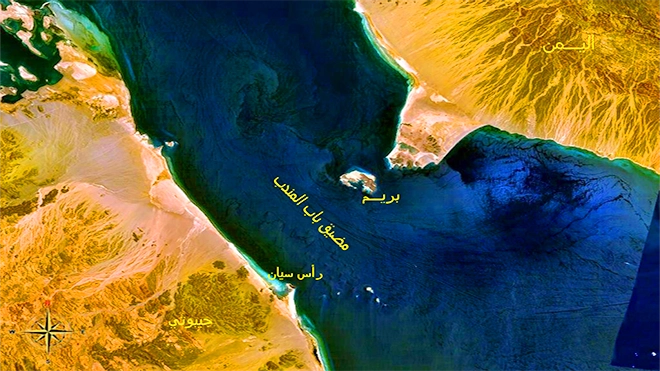> د. هيثم الزبيدي:
لا عيب في الاعتراف بالفشل. بهذا الإقرار أبدأ هذه المداخلة بخصوص وضع النخب العربية في المهجر ودورها الممكن. وعندما ألتفت اليوم إلى كل السنوات الطويلة من الجهد المثابر، أكاد أُصدم بما حدث وما آلت إليه الأمور.
مرت سنوات طويلة، منذ نهاية الثمانينات إلى اليوم، وأنا أعيش في الغرب. استكملت دراستي العليا في بريطانيا ثم قررت الاستقرار هناك وعملت في أكثر من مؤسسة جامعية وبحثية وصحفية.
كان لدي الكثير من الاهتمام بالشأن السياسي العام في بريطانيا من خلال حضور الندوات واللقاءات السياسية الخاصة مع الكثير من الشخصيات العامة. توفرت لي فرصُ إجراء لقاءات مطولة وقصيرة مع مسؤولين غربيين ووجهت لهم الكثير من الأسئلة.
أكتب منذ عقود باللغتين العربية والإنجليزية، وقد أسست موقعا مهتما بالمنطقة العربية باللغة الإنجليزية عام 2000، ثم طورت الحضور في مرحلة لاحقة بإطلاق صحيفة أسبوعية تهتم بشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغة الإنجليزية أيضا عام 2016 لا تزال توزع إلكترونيا ويتم تحديثها يوميا، بعد أن كانت قبل الأزمة الصحية التي سبّبها وباء كورونا تُطبع وتوزع في بريطانيا والولايات المتحدة وتصل إلى أصحاب القرار في البلدين وبعض دول أوروبا.
أعتبر ما تحقق في مؤسسة “العرب” وميدل إيست أونلاين مقبولا بالمقارنة مع حجم الإمكانيات التي أتيحت. لا أعتبر نفسي غرا دخل عالما لا يعرف عنه الكثير، وجاء اليوم يستسهل الحديث عن الفشل.
هنا تنبغي الإشارة إلى أن كل هذا لم يكن جهدا شخصيا بحتا، بل مع فريق صغير من الزملاء المتفانين. كان مهمّا لي ولهم أن يترك مشروع حضورنا أثرا على دول المهجر، وخصوصا بريطانيا والولايات المتحدة، لأننا – مقارنة بالدول الأخرى – سلكنا طريقا أسهل وهو طريق اللغة الإنجليزية، ولأن بريطانيا والولايات المتحدة دولتان تهتمان بالمنطقة اهتماما كبيرا؛ اهتماما يفوق – على سبيل المثال – ما لدى ألمانيا التي لا تزال في حاجة إلى كسر معوقات اللغة بينها وبين العالم العربي، أو مع فرنسا التي حكمت على دورها بالزوال قبل أن يحكم عليه غيرها.
بعد كل هذه السنوات الطويلة، وفي فترة لم تتوقف فيها التغيرات الجيوسياسية عن هز العالم، وعالمنا العربي في القلب منها، أجد أن تأثير النخب العربية على دول المهجر بقي محدودا وأبعد ما يكون عن الفعل المؤسسي ويعاني من تضارب مصالح رعاة أيّ مشروع من مشاريع الحضور الثقافي والسياسي والإعلامي. ليس تضاربا في مصالح بعضهم مع مصالح البعض الآخر فحسب، بل في الكثير من الأحيان يكون تضاربا في مصالح الراعي نفسه عندما يقرر أن يغير، بعد سنوات أو حتى أشهر، رأيه أو أولوياته.
سأقدم مثالا أدلّ من خلاله على عدم قدرة النخب العربية على التواصل وتسجيل حضورها في الغرب.
عندما اشتدت موجة الإرهاب، وبعد أن انتشرت آثار الأخطاء الإستراتيجية الغربية في المنطقة – مثل غزو العراق عام 2003 – لتصل إلى عمق الغرب، قررت الدولة الغربية العميقة الانفتاح على من تعتبرهم ممثلين للجاليات العربية المسلمة في المهجر. مثّل الإرهاب مصدر قلق عميق في الغرب، حيث غيّر الكثير من إيقاعات الحياة اليومية هناك، نورد هنا على سبيل التمثيل لا الحصر تلك الطوابير التي تتراكم أمام مكائن الفحص والتفتيش في المطارات أو عندما يسألك صراف البنك وأنت تسحب مبلغ 100 جنيه إسترليني “ماذا ستفعل بكل هذا المبلغ؟”. البريطانيون مارسوا قلقا مضاعفا: واحد من هجمات يمكن أن يشنها شباب عربي مسلم متشدد في مدن غربية، وثان من ردود فعل انتقامية من “أهل البلد” الأصليين ضد الأقليات المهاجرة.
بدلا من أن يأتي المسؤولون الغربيون ليسألوا “النخب” العربية عن أسباب انتشار التشدد في صفوف المهاجرين أو لماذا تجد رسائل الجهاديين صدى في مجتمعات المهجر والبلاد العربية على حد السواء، قرروا أن يسألوا رجال الدين. اعتقد المسؤولون الغربيون أن العمائم نخب، وأن فهمهم للظاهرة يجب أن يأتي من تفسيرات رجال الدين، وليس من نخب عربية سياسية مهاجرة أو باحثين نفسيين أو مثقفين أو حتى ممن امتهنوا الصحافة وصاروا يرصدون ما يحدث ويكتبون عنه ويوفرون المنبر الوحيد تقريبا للحوار بشأن التغير الكبير الحاصل في مجتمعاتنا العربية، سواء منها التي في بلادنا أو التي في المهجر.
النخب لم تتمكن حتى من اختراق شكليات الحضور، وكان يكفي شكل الجبب والعمائم واللحى لإغراء الدولة الغربية العميقة بأنها ستجد عندها معالجة الظاهرة. بل إن السؤال الأكثر إلحاحا هو: كيف يتوجه المسؤول الغربي بسؤال التفسير ومحاولة العثور على حل إلى المتسببين أصلا في انتشار ظواهر التشدد ورعايتها وإجراء عمليات غسيل أدمغة مُمنهجة بمفردات الإسلام السياسي والسلفية والخمينية.
ولا أبالغ عندما أقول إن الغرب لم يدرك أنه يوجه الأسئلة الجديرة بالطرح إلى “النخب” الخطأ، وإن النخب المنفتحة والعلمانية والموضوعية إما عجزت عن اختراق المنظومة السياسية والبحثية والإعلامية الغربية، أو أنها أنشأت منابرها البحثية الخاصة من مراكز مستقلة أو مؤسسات إعلامية، لكنها لأسباب مختلفة لم تتمكن من تحقيق الهدف.
مرت سنوات طويلة، منذ نهاية الثمانينات إلى اليوم، وأنا أعيش في الغرب. استكملت دراستي العليا في بريطانيا ثم قررت الاستقرار هناك وعملت في أكثر من مؤسسة جامعية وبحثية وصحفية.
كان لدي الكثير من الاهتمام بالشأن السياسي العام في بريطانيا من خلال حضور الندوات واللقاءات السياسية الخاصة مع الكثير من الشخصيات العامة. توفرت لي فرصُ إجراء لقاءات مطولة وقصيرة مع مسؤولين غربيين ووجهت لهم الكثير من الأسئلة.
أكتب منذ عقود باللغتين العربية والإنجليزية، وقد أسست موقعا مهتما بالمنطقة العربية باللغة الإنجليزية عام 2000، ثم طورت الحضور في مرحلة لاحقة بإطلاق صحيفة أسبوعية تهتم بشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغة الإنجليزية أيضا عام 2016 لا تزال توزع إلكترونيا ويتم تحديثها يوميا، بعد أن كانت قبل الأزمة الصحية التي سبّبها وباء كورونا تُطبع وتوزع في بريطانيا والولايات المتحدة وتصل إلى أصحاب القرار في البلدين وبعض دول أوروبا.
أعتبر ما تحقق في مؤسسة “العرب” وميدل إيست أونلاين مقبولا بالمقارنة مع حجم الإمكانيات التي أتيحت. لا أعتبر نفسي غرا دخل عالما لا يعرف عنه الكثير، وجاء اليوم يستسهل الحديث عن الفشل.
هنا تنبغي الإشارة إلى أن كل هذا لم يكن جهدا شخصيا بحتا، بل مع فريق صغير من الزملاء المتفانين. كان مهمّا لي ولهم أن يترك مشروع حضورنا أثرا على دول المهجر، وخصوصا بريطانيا والولايات المتحدة، لأننا – مقارنة بالدول الأخرى – سلكنا طريقا أسهل وهو طريق اللغة الإنجليزية، ولأن بريطانيا والولايات المتحدة دولتان تهتمان بالمنطقة اهتماما كبيرا؛ اهتماما يفوق – على سبيل المثال – ما لدى ألمانيا التي لا تزال في حاجة إلى كسر معوقات اللغة بينها وبين العالم العربي، أو مع فرنسا التي حكمت على دورها بالزوال قبل أن يحكم عليه غيرها.
بعد كل هذه السنوات الطويلة، وفي فترة لم تتوقف فيها التغيرات الجيوسياسية عن هز العالم، وعالمنا العربي في القلب منها، أجد أن تأثير النخب العربية على دول المهجر بقي محدودا وأبعد ما يكون عن الفعل المؤسسي ويعاني من تضارب مصالح رعاة أيّ مشروع من مشاريع الحضور الثقافي والسياسي والإعلامي. ليس تضاربا في مصالح بعضهم مع مصالح البعض الآخر فحسب، بل في الكثير من الأحيان يكون تضاربا في مصالح الراعي نفسه عندما يقرر أن يغير، بعد سنوات أو حتى أشهر، رأيه أو أولوياته.
سأقدم مثالا أدلّ من خلاله على عدم قدرة النخب العربية على التواصل وتسجيل حضورها في الغرب.
عندما اشتدت موجة الإرهاب، وبعد أن انتشرت آثار الأخطاء الإستراتيجية الغربية في المنطقة – مثل غزو العراق عام 2003 – لتصل إلى عمق الغرب، قررت الدولة الغربية العميقة الانفتاح على من تعتبرهم ممثلين للجاليات العربية المسلمة في المهجر. مثّل الإرهاب مصدر قلق عميق في الغرب، حيث غيّر الكثير من إيقاعات الحياة اليومية هناك، نورد هنا على سبيل التمثيل لا الحصر تلك الطوابير التي تتراكم أمام مكائن الفحص والتفتيش في المطارات أو عندما يسألك صراف البنك وأنت تسحب مبلغ 100 جنيه إسترليني “ماذا ستفعل بكل هذا المبلغ؟”. البريطانيون مارسوا قلقا مضاعفا: واحد من هجمات يمكن أن يشنها شباب عربي مسلم متشدد في مدن غربية، وثان من ردود فعل انتقامية من “أهل البلد” الأصليين ضد الأقليات المهاجرة.
بدلا من أن يأتي المسؤولون الغربيون ليسألوا “النخب” العربية عن أسباب انتشار التشدد في صفوف المهاجرين أو لماذا تجد رسائل الجهاديين صدى في مجتمعات المهجر والبلاد العربية على حد السواء، قرروا أن يسألوا رجال الدين. اعتقد المسؤولون الغربيون أن العمائم نخب، وأن فهمهم للظاهرة يجب أن يأتي من تفسيرات رجال الدين، وليس من نخب عربية سياسية مهاجرة أو باحثين نفسيين أو مثقفين أو حتى ممن امتهنوا الصحافة وصاروا يرصدون ما يحدث ويكتبون عنه ويوفرون المنبر الوحيد تقريبا للحوار بشأن التغير الكبير الحاصل في مجتمعاتنا العربية، سواء منها التي في بلادنا أو التي في المهجر.
النخب لم تتمكن حتى من اختراق شكليات الحضور، وكان يكفي شكل الجبب والعمائم واللحى لإغراء الدولة الغربية العميقة بأنها ستجد عندها معالجة الظاهرة. بل إن السؤال الأكثر إلحاحا هو: كيف يتوجه المسؤول الغربي بسؤال التفسير ومحاولة العثور على حل إلى المتسببين أصلا في انتشار ظواهر التشدد ورعايتها وإجراء عمليات غسيل أدمغة مُمنهجة بمفردات الإسلام السياسي والسلفية والخمينية.
ولا أبالغ عندما أقول إن الغرب لم يدرك أنه يوجه الأسئلة الجديرة بالطرح إلى “النخب” الخطأ، وإن النخب المنفتحة والعلمانية والموضوعية إما عجزت عن اختراق المنظومة السياسية والبحثية والإعلامية الغربية، أو أنها أنشأت منابرها البحثية الخاصة من مراكز مستقلة أو مؤسسات إعلامية، لكنها لأسباب مختلفة لم تتمكن من تحقيق الهدف.
اليوم المشهد أمامكم لا يقبل أيّ تفسير آخر. ليس القصد من هذه الكلمات التأنيب الذاتي، فهذا سلوك سلبي لا طائل منه. وعندما بدأت مداخلتي القصيرة هذه بالاعتراف بالفشل، ليس الهدف من ذلك القول بأن مشاريع اشتغلت عليها أو أقامها غيري كانت متعثرة أو ضعيفة، أو غير موضوعية. لكن مثل كل مهندس يحترم عقل من ينظرون إلى الجزء المهدم ممّا شيده، عليه أن يقول إن الأمر يقاس بالنتيجة. وطالما أن المشهد مأساوي ولا يزال مسيطرا عليه من قبَل متشددين أو من طرف غربيين ممّن إلى اليوم لم يفهموا أوضاع منطقتنا -بما تضمه من سكان وشعوب – أو أفكارنا، فإن المهمة لم تتم.
العرب اللندنية