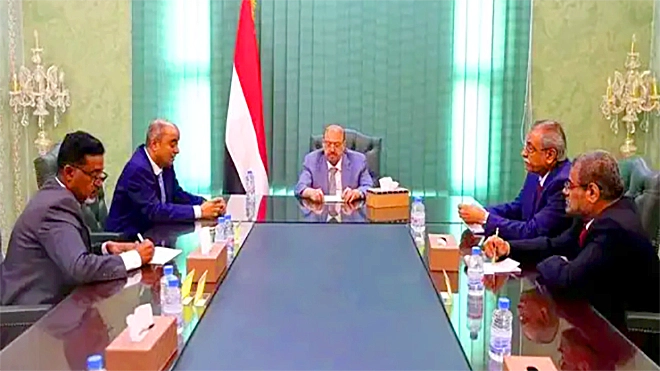في كل صباح، يدخل الطفل إلى فصله حاملًا حقيبته الصغيرة، لا يدري أن بين صفحات كتبه قد يختبئ ما هو أخطر من السلاح، إنه خطاب كراهية متقن الصياغة، ممهور بختم الدولة، يُقدَّم له على أنه "علم" أو "دين" أو "هوية".
وهكذا، بدل أن تكون المناهج التربوية بوابة نحو النور، تصبح أداة لصناعة عقل يرفض، ويقصي، وربما يكره الآخر.
كيف يمكن لكتاب رسمي أن يُعلِّم التحقير باسم التربية؟
بكل بساطة: حين يُصنَّف الناس في الدروس بين "مؤمن" و"كافر"، وحين يُحذف وجود الطوائف الأخرى، أو يُشار إليها بلغة الاستعلاء، وحين تُسرد الحروب الطائفية وكأنها بطولات لا مآسي، وحين تُربط الوطنية بانتماء ديني أو مذهبي محدد.
هنا يتحول الكتاب المدرسي من وسيلة تربية، إلى سلاح أيديولوجي يُعبّئ الطفل ضد أخيه في الوطن والإنسانية.
إن المناهج التربوية هي اللبنة الأولى في عملية التنشئة في كل مجتمع يسعى لبناء الإنسان قبل البنيان. فهي لا تنقل المعلومات فحسب، بل تُغرس من خلالها القيم، وتُصاغ الرؤى، وتُبنى التصورات عن الذات والآخر، وعن الوطن والعالم.
غير أن المتأمل في واقع التعليم في وطننا يجد أن المناهج، بدل أن تكون جسرًا نحو المعرفة والاحترام، قد تنزلق إلى أن تكون أداة لزرع الفرقة والكراهية، تحت مسمى "التربية".
إن أخطر ما يمكن أن تُبتلى به العملية التعليمية هو أن تتحول من مسارها التنويري إلى قناة مغلقة لبث الأحكام الإقصائية. فحين يُقدَّم المختلف دينيًا أو فكريًا في بعض الدروس بوصفه منحرفًا أو مهددًا للمجتمع، وحين تُستخدم مفردات التكفير أو التحريض بشكل ضمني أو مباشر في كتب يفترض أن تهذّب النفوس لا أن تؤججها، فإن الخطر لا يهدد جودة التعليم فحسب، بل يهدد وحدة المجتمع وسلامه.
الطفل لا يولد متعصبًا، ولا يعرف الكراهية بالفطرة. بل يتشرّبها حين يتعلّمها، أحيانًا، من مناهج دراسية صيغت بعقلٍ أحادي الرؤية، أو أُعدّت في لحظة استقطاب لا في لحظة حكمة.
وهنا تبرز أهمية أن تخضع هذه المناهج لمراجعة جادة، لا من باب التجميل أو التحييد، بل من باب الإصلاح العميق الذي ينطلق من سؤال جوهري: أي إنسان نريد أن نصنعه؟
إن تغيير المناهج التي تُكرّس للتكفير والتمييز ليس مسألة تربوية فقط، بل هو ضرورة وطنية. فالمجتمع الذي لا يربّي أبناءه على احترام الآخر، وتوقير اختلافه في الدين أو المذهب أو الرأي أو الفكر، هو مجتمع يُقوّض أسس التعايش السلمي، ويزرع في أجياله القادمة ألغامًا فكرية تنفجر في وجه الاستقرار والتنمية.
نحن في حاجة ماسّة إلى مناهج تعزّز قيم التسامح، وتُبرز التنوع بوصفه مصدر ثراء لا تهديد. مناهج تُعلّم الطفل أن الدين علاقة بين الإنسان وربه، وأن الإنسانية فوق كل خلاف، وأن الوطن يسع الجميع.
وبالمثل، لا بد من رد الاعتبار للمعلم، وتوفير البيئة التي تُمكّنه من أداء رسالته التربوية بعيدًا عن تقلبات الظروف الحالية في اليمن. فالمعلم النزيه، والكتاب المتوازن، هما ركيزتا بناء جيل يُحسن التفكير لا التلقين، ويؤمن بالحوار لا الإقصاء.
إذًا التربية ليست ساحة صراع، بل ساحة بناء. وما نزرعه اليوم في عقول أبنائنا، سنحصد ثماره غدًا في واقعنا. فلنحرص أن يكون الزرع سلامًا، والتربية إنصافًا، والمنهج عدلًا... هكذا سنصنع أوطانًا تعيش، لا أوطانًا تنزف بصمت.
ولأن الطفل الذي نُعلّمه اليوم هو القاضي، والطبيب، والمعلّم، والضابط، وصانع القرار في الغد... فإن كل فكرة نزرعها في عقله اليوم، ستنبت ذات يوم في واقعنا.
فلنزرع فيه ما يستحق أن نحيا به جميعًا: الرحمة، والعدل، والعيش الكريم... معًا.
ودمتم سالمين
وهكذا، بدل أن تكون المناهج التربوية بوابة نحو النور، تصبح أداة لصناعة عقل يرفض، ويقصي، وربما يكره الآخر.
كيف يمكن لكتاب رسمي أن يُعلِّم التحقير باسم التربية؟
بكل بساطة: حين يُصنَّف الناس في الدروس بين "مؤمن" و"كافر"، وحين يُحذف وجود الطوائف الأخرى، أو يُشار إليها بلغة الاستعلاء، وحين تُسرد الحروب الطائفية وكأنها بطولات لا مآسي، وحين تُربط الوطنية بانتماء ديني أو مذهبي محدد.
هنا يتحول الكتاب المدرسي من وسيلة تربية، إلى سلاح أيديولوجي يُعبّئ الطفل ضد أخيه في الوطن والإنسانية.
إن المناهج التربوية هي اللبنة الأولى في عملية التنشئة في كل مجتمع يسعى لبناء الإنسان قبل البنيان. فهي لا تنقل المعلومات فحسب، بل تُغرس من خلالها القيم، وتُصاغ الرؤى، وتُبنى التصورات عن الذات والآخر، وعن الوطن والعالم.
غير أن المتأمل في واقع التعليم في وطننا يجد أن المناهج، بدل أن تكون جسرًا نحو المعرفة والاحترام، قد تنزلق إلى أن تكون أداة لزرع الفرقة والكراهية، تحت مسمى "التربية".
إن أخطر ما يمكن أن تُبتلى به العملية التعليمية هو أن تتحول من مسارها التنويري إلى قناة مغلقة لبث الأحكام الإقصائية. فحين يُقدَّم المختلف دينيًا أو فكريًا في بعض الدروس بوصفه منحرفًا أو مهددًا للمجتمع، وحين تُستخدم مفردات التكفير أو التحريض بشكل ضمني أو مباشر في كتب يفترض أن تهذّب النفوس لا أن تؤججها، فإن الخطر لا يهدد جودة التعليم فحسب، بل يهدد وحدة المجتمع وسلامه.
الطفل لا يولد متعصبًا، ولا يعرف الكراهية بالفطرة. بل يتشرّبها حين يتعلّمها، أحيانًا، من مناهج دراسية صيغت بعقلٍ أحادي الرؤية، أو أُعدّت في لحظة استقطاب لا في لحظة حكمة.
وهنا تبرز أهمية أن تخضع هذه المناهج لمراجعة جادة، لا من باب التجميل أو التحييد، بل من باب الإصلاح العميق الذي ينطلق من سؤال جوهري: أي إنسان نريد أن نصنعه؟
إن تغيير المناهج التي تُكرّس للتكفير والتمييز ليس مسألة تربوية فقط، بل هو ضرورة وطنية. فالمجتمع الذي لا يربّي أبناءه على احترام الآخر، وتوقير اختلافه في الدين أو المذهب أو الرأي أو الفكر، هو مجتمع يُقوّض أسس التعايش السلمي، ويزرع في أجياله القادمة ألغامًا فكرية تنفجر في وجه الاستقرار والتنمية.
نحن في حاجة ماسّة إلى مناهج تعزّز قيم التسامح، وتُبرز التنوع بوصفه مصدر ثراء لا تهديد. مناهج تُعلّم الطفل أن الدين علاقة بين الإنسان وربه، وأن الإنسانية فوق كل خلاف، وأن الوطن يسع الجميع.
وبالمثل، لا بد من رد الاعتبار للمعلم، وتوفير البيئة التي تُمكّنه من أداء رسالته التربوية بعيدًا عن تقلبات الظروف الحالية في اليمن. فالمعلم النزيه، والكتاب المتوازن، هما ركيزتا بناء جيل يُحسن التفكير لا التلقين، ويؤمن بالحوار لا الإقصاء.
إذًا التربية ليست ساحة صراع، بل ساحة بناء. وما نزرعه اليوم في عقول أبنائنا، سنحصد ثماره غدًا في واقعنا. فلنحرص أن يكون الزرع سلامًا، والتربية إنصافًا، والمنهج عدلًا... هكذا سنصنع أوطانًا تعيش، لا أوطانًا تنزف بصمت.
ولأن الطفل الذي نُعلّمه اليوم هو القاضي، والطبيب، والمعلّم، والضابط، وصانع القرار في الغد... فإن كل فكرة نزرعها في عقله اليوم، ستنبت ذات يوم في واقعنا.
فلنزرع فيه ما يستحق أن نحيا به جميعًا: الرحمة، والعدل، والعيش الكريم... معًا.
ودمتم سالمين